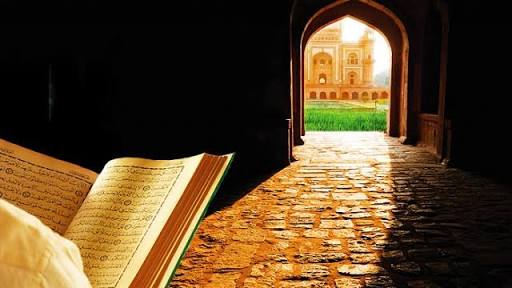من المعروف أن أساس الديانات الإبراهيمية يقوم على الإيمان بالله والنبوة والآخرة؛ لكن مفهوم النبوة يجب أن يحتل مكانة مركزية بين هذه المفاهيم. غالبًا ما يُعتقد أن الإيمان بالله والتوحيد يأتيان أولاً، لكن وجود الله ووحدانيته وصفاته ووجود الحياة بعد الموت وجميع المعلومات الواردة في الكتب المقدسة تعتمد على الأنبياء. لذلك، يجب أن نفهم أنه بدون الإيمان بالأنبياء أولاً، من المستحيل الإيمان بالآخرين بيقين، وأن هذا الإيمان هو شرط ضروري وكافٍ. وبعبارة أوضح، إذا تم الاعتراف بشخص ما بشكل قاطع على أنه نبي، فمن غير القابل للجدل أنه سينقل بشكل موثوق المعلومات التي تلقاها من الله من خلال الوحي إلى الآخرين.
لذلك، من الضروري أن يكون عقل المؤمن واضحًا للغاية وراضٍ فكريًا فيما يتعلق بمسألة النبوة. نظرًا لأن الناس الذين يعيشون في هذا العصر لا يمكنهم إقامة صلة مباشرة مع الأنبياء ولا تتاح لهم الفرصة للاقتناع من خلال معرفتهم شخصيًا، فمن الضروري إثبات أن الإيمان بالرسل ضروري فكريًا. بالطبع، من الممكن العثور على العديد من الأمثلة على هذا المسعى في التقاليد. لكننا هنا سنتناول هذه المسألة بطريقة مختلفة من خلال ثلاث تشبيهات، أحدها مأخوذ من أفلاطون والآخران من المسنفي.
أفلاطون والمثالية في سياق الموضوع
كان لأفلاطون، مؤسس المثالية في تاريخ الفكر، تأثير عميق لدرجة أن أ. وايتهيد وصف الوضع بأن ”تاريخ الفلسفة الغربية برمته هو حاشية لأفلاطون“. وبالتالي، كان على كل مفكر أيد أو عارض أفلاطون أن يواجه أفكاره. أظهرت الحروب التي شهدها أفلاطون وأحداث مثل إعدام معلمه سقراط أن الدعاة والحاكمين غير الأكفاء كانوا مشكلة في أسلوب الحكم في أثينا. لهذا السبب، شرع أفلاطون في محاولة لخلق دولة ونظام اجتماعي مثاليين من خلال الفلسفة. يمكن رؤية محاولة مماثلة في تاريخ الفكر الإسلامي في عمل الفارابي بعنوان ”مدينة الفاضلة“.
كانت المدارس الفكرية التي كانت موجودة في الفترة ما قبل أفلاطونية ترى أن كل شيء في حالة تغير مستمر (هيراكليتوس) وبالتالي فإن المعرفة الثابتة مستحيلة (السوفسطائيون). في هذه الحالة، كان من المستحيل الحديث عن المعرفة الموضوعية والحقيقة والكذب والعدالة والواقع. من ناحية أخرى، واجه أفلاطون، بعد أن تعلم المبادئ الأخلاقية مثل العدالة والخير والفضيلة من سقراط، خيارين: وجود متغير باستمرار ومضلل أو مبادئ مطلقة وجودها مؤكد. يمكن القول أن الفلسفة في العصور الوسطى كانت عبارة عن صراع بين هاتين الفكرتين.
وفقًا لأفلاطون، فإن العالم الذي نعيش فيه ونختبره ليس حقيقيًا لأن ما يُسمى بالواقع لا ينبغي أن يكون عرضة للتغيير، في حين أن العالم الذي نعيش فيه في حالة تغير مستمر. من أجل إرساء معرفة مطلقة ومؤكدة، يجب على المرء أن يتجه إلى عالم قائم على واقع ثابت ولا يتغير، بدلاً من عالم يتغير باستمرار. يقسم أفلاطون عالم الوجود إلى فئتين: المظهر والواقع. العالم الذي نعيش فيه يتكون في الواقع من مظاهر، أي أوهام. عالم الوجود الذي نشهده هو في الواقع نوع من نسخة من عالم الأفكار. السبب الذي يجعلنا نستطيع تجميع الكيانات تحت مفاهيم محددة وإعطاء معنى لعالم الأشياء هو أن هذه الأفكار موجودة في أذهاننا. أعاد كانط التعبير عن التمييز بين المظهر والواقع بعد قرون من الزمن بمفاهيم الاسم والظاهرة.
استعارة الكهف
يمكن وصف هذه الاستعارة المعروفة بإيجاز على النحو التالي:
تخيل مجموعة من الناس جالسين في كهف مظلم، أذرعهم وأرجلهم مقيدة بالسلاسل، ووجوههم موجهة نحو جدار الكهف وظهورهم نحو مدخل الكهف. بفضل الضوء القادم من مدخل الكهف، يرى هؤلاء الأشخاص ظلال أشياء مختلفة في الخارج، مثل الطيور والأشجار والأشخاص، على جدار الكهف. ولأنهم لم يروا العالم ثلاثي الأبعاد والألوان من قبل، فإنهم يدركون الظلال التي يرونها على الجدار على أنها الأشكال الحقيقية لتلك الأشياء. بعد فترة، يتمكن أحدهم بطريقة ما من التحرر من قيوده، ويصل إلى مخرج الكهف، ويحظى بفرصة النظر إلى العالم الخارجي. على الرغم من أن عينيه توهجتا في البداية من الضوء، إلا أنه بعد فترة، عند رؤية الأشياء الحقيقية التي كان يشاهدها على جدار الكهف، يمر بتجربة قفزة ذهنية وعملية تنوير. بعد أن اختبر حالة عظيمة من الوعي، أراد هذا الشخص العودة وشرح الموقف لأصدقائه، لتحريرهم وتعريفهم بالعالم الحقيقي. عندما عاد وحاول سرد تجربته، واجه مقاومة ومعارضة شديدة. عند عودته، اتُهم هذا الشخص البطل، الذي كافح ليرى لأن عينيه لم تكن معتادة على الظلام، بـ “الضلال اتخذ أولئك الذين تم إنقاذهم خطوة كبيرة على طريق الحقيقة من خلال إدراكهم للأشجار الحقيقية والطيور والألوان والشمس والأشياء الأخرى، ولكن هناك سؤال آخر لا يزال بحاجة إلى إجابة: الأشياء التي رأوها على جدار الكهف هي في الواقع ظلال الكائنات التي يرونها الآن، فما هي ظلال هذه الكائنات الخارجية؟
قصة الأربعة رجال
القصة في مسنفي لمولانا هي باختصار كما يلي:
أربعة رجال من دول مختلفة، التقوا في رحلة، يصلون إلى السوق بعد فترة. يقول العربي: ”لنشتري العنب“، بينما يصر الإيراني: ”لا، لنشتري التين“. أحد الاثنين الآخرين، التركي، يقول: ”لا، لنشتري العنب“، بينما يعترض اليوناني قائلاً: ”انسوا ذلك! لنشتري الإستافيل“. غير قادرين على الاتفاق، تندلع بينهم مشادة كلامية حادة وتبدأ مشاجرة. يتدخل أحد المارة الذي يعرف لغات الأشخاص المعنيين، وينهي المشاجرة، ويسألهم عما يريدون. عندما يعبّر كل واحد منهم عن طلبه، يحل الرجل المشكلة قائلاً: ”أنتم جميعاً تريدون نفس الشيء، لكنكم لا تستطيعون فهم بعضكم البعض لأن لغاتكم مختلفة. إن كلمات إينب، إنغور، عنب، وإستافيل تعني جميعها نفس الشيء.“
قصة الأعمى والفيل
هناك قصة أخرى مشهورة من كتاب مولانا ”مسنفي“ يمكن تلخيصها على النحو التالي:
سمع ثلاثة رجال عميان أن حيوانًا يسمى الفيل قد أُحضر إلى ساحة القرية، فقرروا أن يفحصوه. أمسك الرجل الأول بساق الفيل وقال إنه يشبه العمود، بينما أمسك الثاني بأذنه وقال إنه مسطح ويتحرك. أما الثالث، الذي أمسك بخرطومه، فاعترض قائلاً: ”لا، إنه مثل أنبوب“. كان كل منهم متأكداً من تجربته الخاصة والمعرفة التي اكتسبها لدرجة أنهم لم يتفقوا على وصف الفيل. في وقت لاحق، وصل شخص مبصر وحل الخلاف بشرحه أن كل واحد منهم قد قدم ملاحظة صحيحة جزئياً، لكنه أخطأ في وصف الفيل ككل.
ضرورة النبوة
I
في استعارة الكهف، يمثل الشخص الذي تم تحريره بطريقة ما من قيوده وإخراجه من الكهف لمواجهة الحقيقة النبي. والشمس، باعتبارها مصدر الضوء والوجود الذي يمكّن المرء من رؤية وإدراك كل شيء، ترمز إلى الله. الشخص الذي يختبر النور مباشرة (من خلال الوحي) ثم يعود إلى الكهف يواجه صعوبات في شرح وإقناع الأشخاص المقيدين بما يعرفه، مشيرًا إلى الصعوبات المماثلة التي واجهها الأنبياء. من هذا، يمكن للمرء أن يستنتج أنه من غير الممكن السير جماعياً نحو الحقيقة؛ أي أن كل شخص يتحمل مسؤولية نفسه في هذا الطريق وسيقبل عواقب قراراته وفقاً لذلك.
أولئك الذين في الكهف، غير مدركين للضوء والألوان والأشياء الحقيقية ثلاثية الأبعاد، يقبلون بيئتهم على أنها الواقع نفسه. لذلك، لا يمكن توقع أن يشرعوا في رحلة بحث أخرى. لا يمكنهم سماع الحقيقة إلا من فم شخص واحد (النبي) يتم اختياره من بينهم، وإنقاذه، وإخراجه من الكهف. ببساطة، من غير المعقول أن تترك الشمس الأبدية (الله سبحانه وتعالى)، مصدر الحياة والوجود والضوء، الناس في الكهف في الظلام ليتدبروا أمورهم بأنفسهم؛ لذلك، يجب إعلام الناس بطريقة ما، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال الرسل.
في الواقع، يجب فهم الكهف على أنه مكان وفترة زمنية قائمة على افتراضات، تحكمها بشكل أساسي معتقدات خاطئة، حيث الحقيقة محجوبة. بعبارة أخرى، لا ينبغي اعتبار فترة الجهل فترة قد مضت وانتهت، بل فترة لا تزال تُعاش على المستوى الشخصي والاجتماعي. يعتقد الإنسان المعاصر أنه من خلال عمليات مثل عصر النهضة والتنوير والثورة العلمية، قد وصل إلى الحقيقة، وهرب من الظلام، وخرج من الكهف؛ لكن الكهف هو عقل الإنسان المعاصر الذي يفكر بهذه الطريقة. على الرغم من أنه لديه انطباع بأنه هرب جسديًا من الظلام، إلا أنه لا يدرك أنه في الواقع يحمل الكهف داخل عقله. تُظلم الأيديولوجيات والخرافات الحديثة والرغبات قصيرة الأجل وحب الخلود العقل البشري والإدراك، وتحوله إلى كهف.
أولئك الذين أقاموا نظامهم الخاص في الكهف لا يسمحون لأولئك الذين يدركون الشمس بقول الحقيقة ويبذلون قصارى جهدهم لمنعهم. وقد تم تنفيذ هذا العرقلة بطرق مختلفة على مر التاريخ، واليوم يتم ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء القوية. فالأخبار الكاذبة والتضليل يمنعان الناس من رؤية ضوء الشمس، ولا يُسمح لمن هم في السلاسل بتوجيه رؤوسهم نحو الضوء.
أولئك الذين يهربون من ضوء الشمس ويلجأون إلى ضوء مصابيح الشوارع هم، سواء أدركوا ذلك أم لا، سجناء في كهف ويحتاجون على الأقل إلى المساعدة العقلية. إن تصور هؤلاء الناس للوجود والحياة سطحي وبسيط للغاية. يتم التعبير عن هذه الحالة بوضوح في الآية: ”إنهم لا يعرفون سوى المظاهر الخارجية للحياة الدنيا، لكنهم غافلون تمامًا عن الآخرة.“ (روم 7).
يمكن رؤية وصف أفلاطون لعالم الوجود كنوع من نسخة من عالم الأفكار بشكل أكثر كفاءة في المدارس الصوفية. إن عالم الوجود ليس في الواقع سوى مظاهر وانعكاسات لأسماء الله وصفاته. كل شيء يعكس أسماء الله بقدر ما يستطيع. وبصفته الكائن الأكثر شمولاً واتساعاً بطبيعته، يتمتع الإنسان بمكانة خاصة تسمح له بأن يعكس أسماء الله وصفاته.
لا ينبغي أن تؤدي العبارات السابقة إلى استنتاج أن هذا العالم ليس حقيقيًا. الحياة الدنيا تشبه الظل أو الحلم مقارنة بالحياة الأبدية في الآخرة، ولذلك فهي تنطوي على جانب خادع. في الواقع، ”وإنما يعتبرون الحياة الدنيا حقيقة، وهي في الحقيقة ليست إلا لعبًا وتسلية“. محل الآخرة هو الحياة الحقيقية؛ لو كانوا يعلمون” (أنكبوت 64) توضح هذه الحقيقة بوضوح.
II
لا أحد يملك سلطة حيازة الحقيقة في يديه والسيطرة على الآخرين بهذا المعنى. إن سلطة تمثيل الحقائق المطلقة وحدها تتطلب وجود معرفة غير محدودة وشاملة في كل مجال، وهو ما لا يمتلكه أي إنسان. كما في المثال المذكور أعلاه عن الأعمى الذي يصف الفيل، فإن معرفة الإنسان وإدراكه محدودان، لذا لا يمكنه إلا أن يدرك جزءًا من الحقيقة. فقط الشخص الذي فتحت عيناه ويمكنه أن يدرك الفيل تمامًا يمكنه أن يقدم وصفًا كاملاً له. الأنبياء هم أفراد أخرجهم الله من الظلام وفتح أعينهم على الحقيقة من خلال الوحي، ولذلك فإنهم يتمتعون بالسلطة لتمثيل الحقيقة. لو لم يكن هناك أنبياء، لاستمر الجدل بين الأعمى إلى ما لا نهاية ولن يتم حله أبدًا. في الواقع، بالنظر إلى التاريخ، من السهل أن نرى أن الفلاسفة كانوا يتعارضون باستمرار مع بعضهم البعض، بينما كان الأنبياء يؤكدون بعضهم البعض دائمًا. في النهاية، من غير المعقول أن نتوقع من خالق رحيم أن يخلق البشر ثم لا يرسل رسلًا لإبلاغهم بالوجود ومعنى الحياة.
من المعروف أن المجتمعات التي تعيش في مناطق جغرافية مختلفة وتتحدث لغات مختلفة لها أهداف ومساعي معينة نتيجة لكونها بشرية. ومع ذلك، فإن الاختلافات الثقافية والانقسامات التاريخية والجغرافية والتقاليد والاقتصاد وعوامل أخرى متنوعة تجعل من الصعب على الناس أن يتقاربوا ويفهموا بعضهم البعض. في الواقع، كل مجتمع بشري يرغب في السلام والعدالة والوئام والرفاهية المادية والروحية، ولديه حساسية فطرية لمقاومة الاضطهاد والاستعباد. تمامًا كما في قصة الأشخاص الذين أرادوا العنب ولكنهم لم يتمكنوا من فهم بعضهم البعض بسبب اختلاف لغاتهم، على الرغم من أن الناس يرغبون في العدالة والسلام، فإن عدم وجود لغة مشتركة يؤدي إلى الصراع. لذلك، يجب أن يظهر ممثلون قادرون على تجاوز المحلي وتقديم أمثلة عالمية لإعلان أن الجميع يريدون في الواقع نفس الشيء، وقد أُعطيت هذه المهمة للأنبياء.
يخبر الأنبياء الناس على نطاق عالمي أن ”الحياة الدنيا هي نوع من الحلم وأن الناس سيستيقظون عندما يموتون“. ويعلنون أن الناس الذين يدركون زوال الحياة الدنيا لا ينبغي أن يضحوا بحياتهم الأبدية من أجل مكاسب بسيطة. يجب على من لا ينام أن يخبر الناس أن الشخص الذي يملأ نفسه في حلمه لن يستيقظ شبعانًا، أو أن الشخص الذي يجد كنزًا في نومه ويصبح ثريًا لن يجد الماس في فراشه عندما يستيقظ، وأنه لا يوجد ظلم أو عمل صالح لا يكافأ. لا يستطيع أحد سوى رسل الله القيام بذلك.
في النهاية، يدعو رسل الله الناس للخروج من عالم ”المظاهر الظاهرة“ (الكهف) إلى النور والعالم الحقيقي. إن الرسائل العالمية للرسل، الخالية من النزعة المحلية والقائمة على الوحي، قادرة على تقديم حلول لأهم مشاكل البشرية.