آه، ها أنت ذا تعود مرة أخرى!
أيها الوغد الحقير، المتدخل في شؤون الآخرين!
هل جئت لتزعجنا وتكدّر علينا حياتنا من جديد؟
هل جئت لتُعرّض أجسادنا للخطر وتُجبرنا على اتخاذ قرارات جديدة باستمرار؟
لقد كنت سعيداً للغاية. كنت أتمرغ في الوحل والغبار، وأتشمس تحت أشعة الشمس، وأُغلّف الطعام، وأرتشف المشروبات، وأنام على الأرض وأشخر. لقد تحررت من التفكير والتردد: “ماذا أفعل؟ هل أفعل هذا أم ذاك؟”
لماذا عدت؟!
هل جئت لتعيدني إلى تلك الحياة البائسة المقيتة التي كنت أعيشها سابقاً؟”
هذا رد البحّار إلبينور، من “الأوديسه” بعد أن أنقذه أوديسيوس من اللعنة التي حوّلته إلى خنزير، على محاولات أوديسيوس إعادة إلبينور إلى هيئته البشرية، فقد اعتاد إلبينور على حالته الجديدة وأحبها.
هل تحاول الرأسمالية-الليبرالية أن تجعل الناس يعيشون بهذه الطريقة؟
هل يقبل الناس العيش بهذه الطريقة؟
يأكلون ويشربون ويعملون قليلاً؟ ألا يفكرون ويتأملون؟
هل يعيشون فقط، ويستمتعون، ويشترون، ويستهلكون؟
زيجمونت باومان (Zygmunt Bauman) (1925 – 2017)، هو فيلسوف وعالم اجتماع بولندي بريطاني، يُعد أحد أبرز وأعمق المفكرين الذين شخصوا روح العصر في أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين. لم يكن مجرد أكاديمي، بل كان بمثابة طبيب يضع يده على نبض المجتمع الحديث، ليكشف عن أمراضه الخفية وقلقه المستتر. وُلد باومان في بوزنان، بولندا، لأسرة يهودية. شكلت تجربته مع الحرب العالمية الثانية والهولوكوست حجر زاوية في فكره، حيث هرب من الغزو النازي إلى الاتحاد السوفيتي. بعد الحرب، عاد إلى بولندا وعمل أستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة وارسو، لكنه تعرض للملاحقة خلال الحملة المعادية للسامية التي أطلقها الحزب الشيوعي عام 1968، مما أجبره على الهجرة, واستقر في نهاية المطاف في المملكة المتحدة، حيث أمضى معظم مسيرته الأكاديمية. عمل أستاذاً ورئيساً لقسم علم الاجتماع في جامعة ليدز (University of Leeds)
تخصص باومان في النظرية الاجتماعية والنقد الثقافي والفلسفة الأخلاقية، وكان مشروعه الفكري يهدف إلى فهم التحولات الجذرية التي طرأت على المجتمعات الغربية وانتقالها من مرحلة “الحداثة الصلبة” إلى ما أسماه “الحداثة السائلة” (Liquid Modernity).
كان يرى أن هياكل الحداثة القديمة (مثل الدولة القومية، الأسرة المستقرة، الوظيفة الدائمة) كانت “صلبة” وثابتة، تمنح الأفراد شعوراً باليقين والأمان. أما في عصرنا الحالي، فقد ذابت هذه الهياكل وأصبحت “سائلة”، أي متغيرة، غير مستقرة، وعابرة. هذه السيولة تطال كل شيء: الهوية لم تعد هوية الفرد ثابتة، بل أصبحت مشروعاً مرناً يتشكل ويعاد تشكيله باستمرار، خاصة عبر الاستهلاك. العلاقات: تحولت العلاقات الإنسانية إلى “روابط” هشة يمكن تكوينها والتخلص منها بسهولة (الحب السائل). العمل: أصبح غير مستقر ومؤقت، مما يولد قلقاً دائماً.
المجتمع: أصبح مجتمعاً من الأفراد المعزولين الذين يبحثون بيأس عن جماعات للانتماء إليها.
ترك باومان إرثاً فكرياً ضخماً، لكن يمكن تلخيص أبرز أعماله في محورين رئيسيين:
تحليل الهولوكوست والحداثة:
١-الحداثة والهولوكوست (Modernity and the Holocaust – 1989): كتابه الأيقوني الذي قلب فيه الفهم التقليدي للمحرقة. جادل باومان بأن الهولوكوست لم يكن انحرافاً عن مسار الحداثة أو عودة للبربرية، بل كان نتاجاً مباشراً لمنطق الحداثة نفسه: العقلانية الأداتية، البيروقراطية، الكفاءة، والفصل الأخلاقي.
٢-وسلسلة كتب السوائل وهي: كتاب الحداثة السائلة (Liquid Modernity – 2000): الكتاب المؤسس الذي شرح فيه نظريته عن سيولة العالم المعاصر.
وكتاب الحب السائل: عن هشاشة العلاقات الإنسانية (Liquid Love – 2003): يحلل فيه كيف أصبحت العلاقات العاطفية سلعة استهلاكية وعابرة.
وكتاب الحياة السائلة (Liquid Life – 2005): يتناول فيه كيف نعيش حياة تتسم بالقلق الدائم من عدم اللحاق بالركب والتغير المستمر.
وكتاب الخوف السائل (Liquid Fear – 2006): يحلل فيه المخاوف المنتشرة وغير المحددة التي تسود عالمنا.
وكتاب الأزمنة السائلة: العيش في عصر اللايقين (Liquid Times – 2007): استكمال لنظريته حول العيش في عالم متغير.
وكتاب الشر السائل , وكتاب الأخلاق السائلة, وكتاب المراقبة السائلة
وسنكتفي بالحديث عن كتابة الحداثة السائلة لأن الأفكار التي فيه هي مركز وأساس للأفكار الموجودة في الكتب السبعة الأخرى, وكل الأفكار التي فيها تدور حول التي في هذا الكتاب .
بدأ باومان كتابه الحداثة السائلة بسؤال مهم يقول : “ماذا يحدث حين تتحول الأرض الصلبة تحت أقدامنا إلى رمال متحركة، وتذوب اليقينيات التي بنينا عليها حياتنا كما يذوب الجليد تحت شمس حارقة؟ ”
وقد قسّم الكتاب إلى ٥ أقسام , تكلم فيها عن التحرر والفردية والزمان\المكان والعمل والجماعة\المجتمع
والآن سنعرج بعجاله على كل مفهوم من هذه المفاهيم
الفصل الأول: التحرر.. هبة الحرية ولعنة العجز
يبدأ باومان رحلته بتساؤل يزلزل المسلّمات: هل الحرية هبةٌ أم لعنة؟ في عالمنا المعاصر، يُمنح الفرد حرية اختيار غير مسبوقة، لكنها حرية تأتي مقيدة بعجزٍ غير مسبوق أيضاً. إنها حرية تمنحنا إياها بيد، وتسلبنا القدرة على إحداث تغيير حقيقي باليد الأخرى. فالمجتمع الحديث يرحب بالنقد فقط طالما ظل عاجزاً عن الفعل، مقدماً لنا وهم السيادة في عالم لا نملك فيه سيادة حقيقية.
الفصل الثاني: الفردية.. خلاص الاستهلاك في مواجهة الوحدة
هنا يتجلى الفارق بين رأسمالية الأمس “الثقيلة” ورأسمالية اليوم “الخفيفة”. لقد تفككت السلطة التي كانت تأمر وتنهي، لتحل محلها سلطات لا تأمر بقدر ما تغوي وتتودد. وهكذا، يجد الفرد نفسه وحيداً في مواجهة العالم، مسؤولاً عن “خلاصه الفردي” بعد أن تلاشت الروابط الاجتماعية الحقيقية. في هذا الفراغ، يصبح الاستهلاك هو الهوية، وعربة التسوق هي محاولة يائسة لبناء الذات واستمداد الأمان من الأشياء.
الفصل الثالث: الزمان والمكان.. في معابد الاستهلاك وفضاءات العزلة
في هذا العالم السائل، يذوب المكان والزمان أيضاً. لم تعد المدينة ذلك الملتقى الدافئ، بل تحولت إلى فضاءات محصّنة ضد الخطر. يبدع باومان في صك مصطلح “معابد الاستهلاك”؛ حيث تجتمع الحشود لا لتتواصل، بل ليحتفل كل فرد بعزلته، منغمساً في طقوسه الاستهلاكية الخاصة. أما الزمن، فيفقد خطه المستقيم، ليتحول إلى سلسلة من اللحظات الخاطفة، لحظات “الآن” التي لا جذور لها في الماضي ولا أفق لها في المستقبل.
الفصل الرابع: العمل.. من حرفة مقدسة إلى متعة عابرة
أما العمل، الذي كان يوماً ما العمود الفقري للهوية، فقد تبخر معناه. لم يعد ذلك المحور الآمن الذي تُبنى حوله مشاريع الحياة، بل تحول إلى شظايا من مهام مؤقتة. لقد اكتسب العمل دلالة جمالية؛ فالمطلوب منه ليس أن يكون نافعاً، بل أن يكون “ممتعاً” للفرد. وهذه السيولة في العمل تذيب معها الروابط الإنسانية، وتكرس حالة من القلق الدائم، حيث تلتقي سياسة “العمل المؤقت” مع سياسة “الحياة المؤقتة” في نتيجة واحدة: تفسخ الروابط الإنسانية.
الفصل الخامس: الجماعة.. حنين إلى الانتماء في زمن التشتت
إلى أين يفر هذا الإنسان المنهك؟ يفر، كما يقول إريك هوبزباوم، باحثاً بيأس عن “جماعة يمكن أن ينتمي إليها في ثقة ويقين”. لكن حتى هذا الملاذ الأخير يبدو مراوغاً. ففي ظل دولة تخلت عن دورها في توفير الأمان، نواجه التناقض الأعظم: الخوف من الآخر الذي يدفعنا للانعزال، وفي الوقت نفسه، حاجتنا الماسة إليه لنسد فجوات أرواحنا.
الخلاصه
في اقتباس الأوديسه عن البحار إلبينور الذي قرأته في بداية المقال, قد تعمّدت وضعه في البداية , لأني أردت أن أربط بينه وبين الرأسمالية, لأني أعتقد أن الرأسمالية، وإن كانت بنسب متفاوتة، قد نجحت في تحويلنا إلى هذا النموذج الذي تُفضّله لإطالة فترة بقائنا على قيد الحياة. أقول بنسب متفاوتة، لأنها نجحت مع البعض نجاحاً باهراً، بينما لم تُفلح مع البعض الآخر بنفس القدر.
يحلل بومان في الحداثة السائلة كيف تُسوّق الرأسمالية لنا، وكيف تُقطّع الأواصر الإنسانية بيننا، وكيف تُمزّق المجتمع، وكيف تُحوّله من جماعة ذات هدف واحد ومصير واحد إلى أفراد ذوي مصالح مُتباينة، بل ومتناقضة أحياناً، وكيف تُحوّل العلاقات الأسرية والوثيقة من علاقات دائمة إلى علاقات عابرة قائمة على الإشباع والرغبة، وكيف يؤثر هذا النمط من التفكير على علاقتنا بالدولة أو بالوطن الذي نعيش على أرضه وتحت سمائه. لقد تحولت العلاقة بين المواطن والدولة إلى علاقة عابرة قائمة على تبادل المصالح والخدمات، واختفت مفاهيم الانتماء والولاء ومصلحة الوطن والصالح العام.
تُشير دائرة المعارف البريطانية إلى أن المواد السائلة والغازية لا تحتفظ بقوى التماسك بين جزيئاتها حتى في حالة السكون.
وكما يُشير بومان، لهذا السبب تُسمّى حداثتنا بـ “الحداثة السائلة”. يعكس هذا الوصف بشكل دقيق واقع حياتنا المعاصرة التي تتسم بالانفصال والتشرذم والمفاجآت والسيولة.
تتحرك السوائل بسهولة، وتتدفق، وتنسكب، وتتشتت، وتتسرب، وتفيض، وتذوب، وتقطر. ليس من السهل إيقافها.
لذلك، تُصبح السيولة أو الحالة السائلة استعارة مناسبة لفهم طبيعة هذه المرحلة من الحداثة.
تجعل ما بعد الحداثة أو الحداثة السائلة من الذوبان هدفاً وغايتاً في حد ذاته، ولا تسعى إلى الوصول إلى حالة نهائية. إنها تقوم على التحديث المستمر، ما يُطلق عليه بومان “التحديث الوسواسي القهري”. كل لحظة هي جسر مؤقت إلى اللحظة التالية، إنها حلول وسط مؤقتة لا نهاية لها، وليس هناك نموذج أو وجهة أو نظام يُسعى إلى الوصول إليه. لا تُؤمن الحداثة السائلة بوجود نموذج. الشيء الثابت الوحيد هو التغيير. اليقين الوحيد هو عدم اليقين. الفكرة الصلبة الوحيدة هي السيولة. الهدف هو الاستمرار في الجري. يتم تشجيع هذا من قِبل الرأسمالية الاستهلاكية التي لكل شيء فيها تاريخ انتهاء صلاحية، والتي تسعى إلى تحديث حياتنا باستمرار. الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي البقاء في السوق. ولا يقتصر التسوق هنا على الطعام والأحذية والسيارات، بل هو بحث لا ينتهي عن نمط حياة أفضل. ولكن ماذا يعني الأفضل؟ أفضل من الحالي. وعندما تصل إليه، ستبحث عن نموذج أفضل منه. هذا يتضمن شعوراً دائماً بالنقص والافتقار، وقلقاً مستمراً.
تشجع الحداثة السائلة الفردانية حيث يتحمل الفرد مسؤولية تحقيق مصالحه الشخصية. لقد حلّت العقلية قصيرة المدى محل العقلية طويلة المدى، وهذا انعكس على وظائفنا وعلاقاتنا الشخصية. لقد اجتاحت سيولة الحداثة السائلة حياتنا بأكملها..
“الحداثة السائلة” ليس مجرد كتاب، بل هو مرآة صافية ومؤلمة نرى فيها انعكاس قلقنا المعاصر. إنه دعوة للتوقف والتأمل في السيولة التي تغمر كل شيء حولنا، قبل أن تجرفنا معها إلى مصير مجهول.
لذلك حين يباغتُك الذهولُ أمام شاشات الأخبار، وتتساءل كيف لروحٍ تقطنُ في أقاصي الأرض أن تصير سيفًا مسلولًا باسم عقيدةٍ لم تعايشها، فتُزهق الأرواح في ليلٍ صاخب… انظر في صفحات هذا الكتاب.
وإن أغراك بريقُ هاتفٍ جديد لتحجب به خواء هاتفٍ لم يكد يشيخ بين يديك، أو إن أحسست بأن وشائج القربى قد بهت لونها وتلاشت حرارتها، فباتت مجرد صورٍ باهتة على جدران الذاكرة… ففي هذا الكتاب عزاؤك.
وإن شعرت بأن الزمن يركض لاهثًا، يسرق من بركة أيامك، أو حين تجد نفسك أسير التساؤل عن هوية الفاعل قبل أن تسأل عن ماهية الفعل، أو يلسعك قلق المستقبل لأن اسمك لم يُدرج في سجلات الأمان الوظيفي… فستجد بين طيّاته ضوءًا يكشف لك هذا الظلام.
وإن لم تجد متسعًا من وقتك لهذا الكتاب، فاعلم أنك أحوج الناس إلى أن تخلق له وقتًا، لتغوص في أعماق فكر زيجمونت باومان قبل أن تجرفك أمواج هذا العصر.
تعقيبا ختاميا على أفكار الكتاب وعلى آلام فرد هذا العصر
يقول إد شيران : إن النادي ليس أفضل مكان للعثور على الحب.
لذلك يذهب إلى الحانة ويقع في حب الأشكال والهيئات والقوالب.
في عالم تسوده المادية والأنانية،
يُختزل الناس إلى رغباتهم الأساسية وملذاتهم الجسدية، وتتحول الحياة إلى سباق محموم لالتهام كل شيء ومضغه واستهلاكه وبصقه،
الرغبة في المزيد والمزيد إلى الأبد ودون شبع،
ولا يملأ عين ابن آدم غير التراب”.”
يفقد كل شيء معناه وتسيطر المخاوف العميقة على الناس.
الحياة جحيم والجميع معرّضون لهذا الجحيم:
جحيم المواهب والجسد والنجاحات.
لكن الوقت يمر والعمر يتقدم وقيمة السوق تنخفض،
فماذا يفعل الناس؟ يزدادون جشعاً.
يخافون من الموت والشيخوخة.
يعبدون الشباب والقوة ومظاهرهما، ويبذلون قصارى جهدهم لمحاربة الزمن.
لكن صراع الإنسان مع الزمن خاسر لا محالة.
قرآن”إن الإنسان لفي خسر”.
وهو في خسر لأن الزمن يمضي ويسحق كل شيء في طريقه،
ولا سبيل لمقاومته أو إيقافه أو إلغائه أو استعادته.
في هذا العالم حيث الفرصة تأتي مرة واحدة فقط،
يتسع مفهوم الشر ليشمل كل أنواع المشقة.
كل حزن وكرب وتعب،
هي “مشاعر سلبية” ظالمة يجب قمعها بالتفكير.
يصبح الفقر والحزن عيوباً أخلاقية.
أنت فقير لأنك لم تعمل بجد كافٍ،
وأنت حزين لأنك لم تفكر بإيجابية كافية،
وللأسف لا أحد يريد أن يعرفك.
تسيطر المخاووف العميقة على الناس.
ماذا سيفكر الناس في شعري الخشن، أنفي الكبير، وزني الزائد، أو تجاعيد أسفل عيني؟
كيف سيقارن هؤلاء الناس سيارتي ورحلتي إلى نيكاراغوا بحياتهم البائسة والفاشلة؟
الوقت يمر والشباب يذبل،
ومكانتي الاجتماعية تتراجع، والملذات الحالية تتضاءل،
ولن تبقى لي قيمة قريباً.
هذا هو الخوف العميق الذي يحرك الناس.
خوف الزمن.
خوف نجاحات الآخرين ومظاهرهم.
خوف الهوة بين محدودية الإمكانات البشرية والرغبات غير المحدودة.
ولذلك، ينغمسون في اللهو هرباً من الأسئلة الحتمية،
ويبحثون عن عوامل تشتيت لا حصر لها.
يذهب الناس إلى الحانات الصاخبة حيث تمنعهم الموسيقى من سماع أفكارهم،
ولا يفعلون شيئاً سوى “التحدث مع أصدقائهم”.
أعظم مخاوف إنسان هذا العصر هي:
خوف أن يكون إنساناً عادياً: الخوف من عدم الشعور بالتميز، الخوف من رؤية نفسه مجرد موظف أو إنسان عادي بينما كل من حوله من الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين والمشاهير. هذا يؤدي إلى البحث عن هوية مميزة، إلى بذل الجهود لتمييز نفسه في عالم لم تعد فيه الهويات ذات أهمية.قلق العادية: هذا القلق يُرهق الإنسان، ويُسهره ليلاً، ويجعله يُعيد النظر في قرارات حياته وخياراته الشخصية.خوف الوحدة: يلجأ الناس إلى كل أنواع السلوكيات لقمع هذا الخوف. مثل سماع الموسيقى الصاخبة، والهدف هو كبت ألم الوحدة والغربة.خوف فقدان الذات: ينبع هذا الخوف من الخوف من فقدان أنفسنا. نشعر بالحاجة إلى إيجاد أنفسنا في ذات أخرى تُؤكد وجودنا.لدى لحامد غزالي قول جميل في هذا الصدد:
“لا يشعر الإنسان بالوحدة إلا حين ينفرد بنفسه، ولهذا يجتمع الناس بالناس وينشغلون بهم ليدفعوا عن أنفسهم وحشة الوحدة”.
كان القدماء يتجمعون أفواجاً ويقرعون الطبول مستخدمين المشاعل والقناديل لطرد الوحوش.
خوف الوحدة ينبع من الخوف من فقدان ذواتنا. نشعر بالحاجة إلى إيجاد أنفسنا في ذات أخرى تُؤكد وجودنا.
وهكذا، عندما ينفرد الإنسان بنفسه، يُشغّل التلفاز أو الراديو، باحثاً عن أصوات تُبدّد وحشة الصمت. يخاف هؤلاء الناس من شيء مجهول.
مصدر هذه المخاوف هو جنون الاستهلاك الذي يفرضه العالم الرقمي الحديث ومنصات التواصل الاجتماعي، وإلغاء الفردية. الرأسمالية تستغل ذواتنا وهوياتنا لتتوحش وتثرى.
هذا يقود إنسان هذا العصر إلى العبثية.
في النهاية، إنسان هذا العصر هو فرد تائه في بحثه عن الذات والهوية، يُصارع خوف الوحدة والعبثية.
لكن هذه ليست هي النظرة الوحيدة للعالم.
في حضارة أخرى، الموت ليس النهاية، بل هو لقاء الله، والحياة ليست ساحة للتنافس والسعي وراء المتعة، بل هي فرصة لسمو الإنسان وتزكيته والاستعداد لما بعد الموت.
في هذه الحضارة، لا تنخفض قيمة الناس بتقدمهم في السن وتضاؤل ملذاتهم، بل إن التقدم في السن يعني راحة الروح، والاقتراب من الله، والاستعداد لتلقي حكمته ونوره.
“الشيخوخة نعمة”.
في تلك الحضارة، لا يُنظر إلى الأشياء على أنها مجرد سلع استهلاكية. فالطعام نعمة من الله ويستحق الاحترام، والمسرفون إخوان الشياطين.
لا تكمن قيمة الإنسان في مظهره. فهناك أولياء الله المتخفون، و”لعبد لله مغبر يتمنى لو أقسم على الله لأبره”.
يُذمّ التعلق المفرط بالدنيا، وليس للإنسان تصرف مطلق فيها، إنه خليفة الله في الأرض، يفعل كل شيء باسم الله.
يؤمن بالغيب، مما يحفزه على فعل الخير في الخفاء “لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك” ويبتعد عن الكبر والغرور والرياء.
لأن باطن الإنسان لا يقل أهمية عن ظاهره. يُفضّل الإنسان مراقبة الله وحده على مراقبة الناس جميعاً.
لا تُصنّف المشاعر إلى إيجابية وسلبية، “كل شيء من عند الله”. “هو الذي يُضحك ويُبكِي”.
في عالم هي فيه الدنيا وسيلة وليست غاية، يتحمّل الناس الأحزان والأفراح.
“عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له”.
يرضى الإنسان بقضاء الله خيره وشره، وهذا يُقلل من مشاعر الذنب والغرور.
يُسلّم لكل شيء، لأن الأمور قضاء وقدر، والله خلق كل شيء. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
في ذلك النظام، يُذمّ كل أنواع الأنانية. فعندما ينتفخ ego الإنسان إلى حد معين، يُبعده عن الدين، عن الحب الصادق، ويُجرّد الأشياء من معانيها، والحياة من معناها.
يدعو هذا النظام إلى أن عبودية النفس هي أصل كل الشرور، وأن السعي وراء اللذة ليس إلا سراب.
“ويل لعبد الدرهم، وعبد الدينار، وعبد الخميصة، وعبد القطيفة!”.
الشيء الوحيد الذي يُخلّص الإنسان من كل هذه الشقاوة هو التوجه إلى الله.
“وإلى ربك المنتهى”.
“وإلى ربك المصير”.
قيم جميلة يحتاجها العالم، قادرة على إنقاذ ملايين البشر التعساء.
ولهذا العالم الخيار إما جحيم الحداثة السائلة أو الإسلام

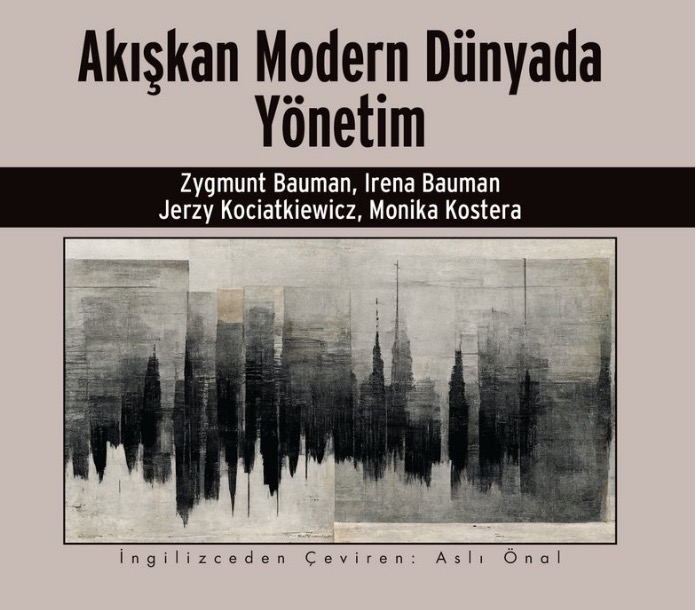

[…] زيجمونت باومان ونقد الحداثة – Kritik Bakış, , https://kritikbakis.com/ar/%D8%B2%D9%8A%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A7… […]