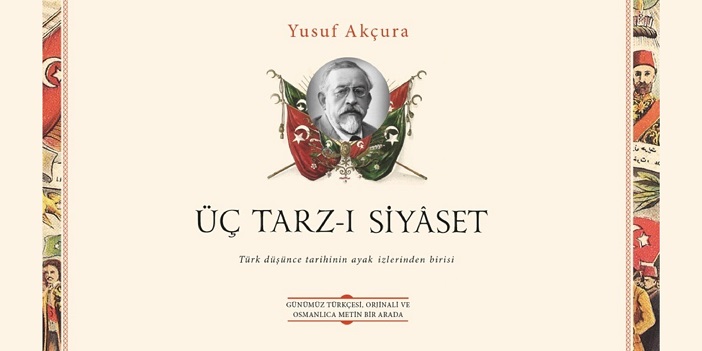ملاحظة: نُشر هذا المقال لأول مرة في مجلة يارين في عام 2004. كان أكجورا، مثل توفيق فكريت وعبد الله جودت، شخصية علمانية، أو بالأحرى معادية للإسلام، أدارت ظهرها للإسلام في عصر الهزيمة الكبرى، غير راضية عن هويتها الإسلامية، تمامًا مثل أولئك الذين هم على الموضة اليوم. خلال العصر الدستوري، تم تهميشه لأنه لم يستطع كسب ود الاتحاديين، وخاصة إنفر باشا. خاصة بعد لوزان، عندما تم تأسيس النظام الأنجلو-فرنكوفوني المسمى الجمهورية، لم يحصل أكجورا في النهاية على ما يريده من قوميته التركية، التي كانت متوازية مع الكمالية في التعريف التركي الذي يرضي الغربيين. أي المعنى الذي أضفاه على مفهوم التركية، اكتسب مضمونًا بعيدًا جدًا عما كتبه في عام 1904. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه المقالة لا تتناول مضمونًا أيديولوجيًا بل مناقشة استراتيجية للاتجاه، فقد وجدنا أنه من الجدير كتابة رسالة مفتوحة. نقدم لكم هذه المقالة النقدية، التي نُشرت في الذكرى المئوية لكتاب ”الأنماط الثلاثة للسياسة“، مع هذه الملاحظة. (أحمد أوزجان)
——————————————
إذا سقطت الأمة، فلا تعتقد أن مجدها قد تضاءل؛ فالسقوط على الأرض لا يقلل من قيمتها أو قيمتها /
خادم الظالم في هذا العالم هو شخص حقير، كلب يستمتع بالخدمة دون رحمة /
فليجمع القدر كل أنواع أسباب الشقاء وليأتي، إذا تراجعت، فأنا خائن لقضية الأمة /
يا لك من ساحر. آه، يا وجه الحرية، كنا أسرى الحب، رغم أننا تحررنا من الأسر.
نامق كمال
عزيزي يوسف أكشورا،
أعتقد أن قرنًا قد مضى، أم تسعة وتسعون عامًا؟ ما السر وراء الأهمية المستمرة لمقالك* المنشور في مجلة ”Türk“ في مصر عام 1904؟ هل هو المحتوى، الأسئلة التي يطرحها، أم ”الطريق الجديد“ الذي يوحي به؟ الفيلسوف الفرنسي ج. ديلوز، في كتابه ”ما هي الفلسفة؟“، يقول إن الفلسفة في اليونان القديمة بدأت بـ”خلق المفاهيم“ وأن كل ما كان معروفًا في مصر وميسوبوتاميا وإيران والهند في تلك الأيام أُعطي ”اسمًا“ في المدن اليونانية. وبالتالي، يتم ”تسوية“ ’الفكر‘ من خلال المفاهيم، ويتطور ما تسميه الفلسفة، أي ”التفكير في غير المفكر فيه“. هل يمكن أن يكون مقالك هل احتفظ مقالك ”ثلاثة أنماط من السياسة“ بأهميته لأول مرة بهذا المعنى لأنه ”سمى المعلوم“؟
العثمانية، الإسلاموية، التركية… بالطبع، حقيقة أنك كنت أول من ذكر التركية كبديل إلى جانب الأولين تحمل معنى منفصلاً. لكن الطريقة التي تعاملت بها مع هذه القضايا، بلغة هادئة وموضوعية، محللاً كل خيار في علاقتها بالواقع، كانت أيضاً الأولى في تقاليدنا الفكرية. لذا، لننسب الفضل إلى من يستحقه: ”ثلاثة أنماط من السياسة“ يقدم ”تقنية نظرية“ ذات صلة ليس فقط بالفترة التي كُتب فيها، بل أيضاً باليوم. يناقش الخيارات المتاحة لنا، وإيجابياتها وسلبياتها، وجدواها، وصعوباتها، ومخاطرها المحتملة، تمت مناقشتها بأكثر العبارات إيجازًا ممكنة – بالنسبة لأولئك المطلعين على الموضوعات، بالطبع. ربما لأننا فقدنا أسلوب ”المناقشة“ هذا منذ زمن بعيد، وجدت هذا النهج ”التقني“ أكثر إثارة للاهتمام من محتوى مقالك. يجب أن أضيف أيضًا أنك ولدت في عائلة ثرية في قازان، وانتقلت إلى اسطنبول بعد وفاة والدك، وأقمت اتصالًا مع حركة جونتورك في الأكاديمية العسكرية وتم نفيك، ودرست التاريخ السياسي في فرنسا، ثم توليت إدارة مصانع عمك في قازان. ومع ذلك، لم تستطع تحمل فكرة أن ”البعض يجب أن يخسر الكثير حتى يربح الآخرون الكثير“، على حد تعبيرك، فاخترت حياة أكثر مثالية وعُدت إلى اسطنبول بعد إعلان الملكية الدستورية في عام 1908. . يجب أن أقول إن هذه المغامرة، التي يمكن اعتبارها قصة حياة عادية لأقرانك في ذلك الوقت، تبدو ملفتة للنظر اليوم، على الأقل من حيث تأثيرها على مراسلاتنا. فحتى بين أولئك الذين يشاركونك أفكارك القومية التركية، لم يعد هذا ”المثالية“ يعتبر ”مربحًا“ أو ’مجزًا‘ أو ”واقعيًا“ في عصرنا. لم يعد هناك ما يثير الناس سوى ما يعدهم بمكاسب دنيوية. ربما هم على حق، لا أعرف. ففي النهاية، المثاليون يصممون التاريخ، والواقعيون يجنون الثمار. الجميع يختارون طريقهم وهم يعلمون ذلك.
عزيزي السيد أكجورا،
قبل أن أصل إلى مضمون مقالك، أود أن أذكر نقطة أخرى. لسوء الحظ، ما زلنا في نفس المكان بعدك… ما زلنا لم نختر أسلوبنا السياسي. نحن ”ننتظر“ باستمرار عند مفترق طرق. لقد حصلنا على قطعة أرض متواضعة في هذا العالم، ونقف حراسة عليها، تحسبًا لأن يأخذوها منا. ليس لدينا أي عمل جاد سوى ملء اليوم، وقضاء الوقت، وكسب المزيد من الوقت الخالي من المتاعب. لا تسيئوا فهمي، نحن لسنا مسالمين أو سعداء للغاية. لقد تسببنا في انقسامات وصراعات غير مسبوقة من مشاكل بسيطة للغاية؛ نحن نكافح. لقد أطلقنا العنان لجميع أرواحنا الشريرة ودوسنا على جميع مهاراتنا المعروفة. نحن نكره أنفسنا ونبول على بعضنا البعض لنلفت انتباه الآخرين. إذا لمسونا، سننهار؛ إذا لمسونا، سنخسر الكثير؛ إذا لمسونا، سنبكي…
لقد ضحينا بالعديد من أطفالنا في معارك عقيمة، كما تعلمون. كم من الأبطال ضحينا بهم من أجل أصنام جوفاء… والآن يقتلون أطفالنا دون حتى أن يقاتلوا. إنهم يضحون بهم بمحو أرواحهم وشخصياتهم وآمالهم. لقد وصلنا إلى النقطة التي نقول فيها: لو فقط؛ لو فقط استطاعوا أن يعيشوا من أجل هدف، كما فعلوا في الماضي، ويموتوا وهم يقاتلون، حتى لو كان ذلك كذبة. لو فقط لم يكن من السهل فقدانهم…
لقد كنا هكذا منذ ما يقرب من خمسين عامًا، سيد أكجورا. لقد اعتدنا على العيش بدون اتجاه، بدون هدف، بدون اهتمام. مهما كان ما ارتبطنا به، ظللنا ”مرتبطين“ به. الدولة بالنسبة للغرب، ونحن بالنسبة للدولة، كما لو كنا ”رهائن“. أحيانًا نتحدى، وأحيانًا نستسلم. في كل الأحوال، نحن عالقون في شبكة من العلاقات ”الرهينة“. نحن نبذل شخصياتنا لكسب المال، وإيماننا لكسب السلطة، وأرواحنا للارتقاء. لن تصدقوا ذلك، لكننا لا نعرف حتى ما تعهدنا به للبريطانيين إلى جانب ديننا لإنقاذ دولتنا وأرضنا. أولئك الذين يعرفون يضربوننا في كل فرصة بأعذار لا معنى لها. يقولون: ”اصمتوا، اجلسوا، لا تتكلموا، لا تفكروا، لا تسألوا“.
لم نضل طريقنا، سيد أكجورا، نحن فقط لم نختر طريقنا بعد. ما زلنا لا نملك أسلوبًا سياسيًا. لكن ما زال لدينا خيارات لأسلوب سياسي.
في بداية القرن العشرين، عندما كان حكم السلطان حاميت الاستبدادي يؤخر الانهيار، كان هناك جدول أعمال للاختيار بين الحفاظ على ما هو موجود (العثمانية) واتخاذ مسار جديد (الإسلاموية والتركية). لكن ألم نكن بالفعل عثمانيين ومسلمين وأتراك؟ بالطبع، كان هناك من انتقد مقالك قائلاً: ”كنا كذلك“. لكن حتى في ذلك الحين، أعتقد أنه من الحقائق أنهم لم يفهموا ما قصدته بهذه ”الخيارات“.
علينا توضيح ذلك أولاً. تُناقش ”أساليب السياسة“ هذه باعتبارها ”السياسة الخارجية“ التي ستتبعها الدولة من أجل وجودها وبقائها. من المعروف جيداً أنك ولا أولئك الذين يتناولون هذه القضايا في سياقك لا تنوون التشكيك في الأصول الدينية أو العرقية. أقول هذا للسبب التالي: بعدك، لأننا فقدنا القدرة ”النظرية الفنية“ التي ذكرتها في البداية، تطورت قدرتنا على خلط التفاح بالبرتقال. لهذا السبب، تصبح السياسة المدفوعة بالوجود والبقاء مرادفة لإنكار ”الوجود والبقاء“، على سبيل المثال. عندما نتخلى عن سياسة ”الإسلاموية“، فإننا نحاول أيضًا التخلي عن هويتنا الإسلامية؛ وعندما نتخلى عن التركية، فإننا نحاول بناء هويتنا التركية على خصائص ”غير تركية“. منذ أن تخلينا عن العثمانية، أصبحت ألسنتنا متعبة من شتم كل ما يتعلق بالعثمانيين. ومع ذلك، سيد أكجورا، نحن ”وجودنا“؛ سواء أعجبنا ذلك أم لا، نحن ’عثمانيون‘ و”مسلمون“ و”أتراك“. في عيون الغربي العادي، بغض النظر عما نفعله، نحن استمرار للإمبراطورية العثمانية، تمامًا كما أن أكثرنا إلحادًا هم ”مسلمون“ وأكرادنا وألباننا وشركسنا هم ”أتراك“. هذه الخصائص الثلاث هي، إذا جاز التعبير، ”WASP“ الخاصة بنا. وفي النهاية، فهي أمر لا جدال فيه. لأننا عندما نتحدث عن وجودنا، وبقائنا، ودولتنا، وأمتنا، ووطننا، فإننا نعني دائماً هذه الأشياء التي تنتمي إلى ”نحن“ الضمني. نقيض إسلامنا هو المسيحية، ونقيض تركيتنا هو الكفر. نقيض عثمانيتنا هو الأوروبية. ولكن ربما لأننا غير قادرين على اختيار اتجاه، بل وبعيدين كل البعد عن تقنية ”اختيار الاتجاه“، تمكنا من وضع إسلامنا في مواجهة التغريب، وتركيتنا في مواجهة ”الكردية“، وعثمانيتنا في مواجهة العصر الجمهوري! ونتيجة لذلك، لم نفشل فقط في وضع سياسة غربية متوازنة واستراتيجية تحديث، بل إن إسلامنا وتركيتنا وكرديتنا وهوياتنا الفرعية الأخرى أصيبت بجراح وندوب.
لقد عانينا من هذا الارتباك بشكل حاد في مجال التغريب، سيد أكجورا. في النهاية، فإن التغريب، الذي هو سياسة أمنية للدولة، أي أن نصبح مثل الغرب ونصبح أقوياء ونسلح أنفسنا بأسلحتهم ضد أي هجوم محتمل من الغرب، قد أوصلنا اليوم إلى نقطة تغيير حضارتنا وديننا وهويتنا وتدمير أنفسنا تمامًا. في حين أن البديل للتغريب هو التشرقيّة، وعكس الحداثة هو الحضارة الزراعية ما قبل الحداثة، والبديل لأوروبا هو أمريكا أو روسيا، كنا دائمًا ”نفكّر“ بإضافة ”الكمثرى“ إلى هذا الاختيار من التفاح. لقد وضعنا ديننا في منافسة على كل المستويات؛ كانت هناك أيام كان فيها ”الإسلام“ هو البديل للغرب، وأيام كان فيها البديل للحداثة أو العلمانية والديمقراطية والجمهورية… لم نأخذ الإسلام كنقد لـ”دين“ أو عقيدة أخرى، بل كنقد للتطورات الاجتماعية هنا وهناك. ”الوثنية“، أنظمة العبودية للإنسان، بل كـ”منافس“ للأنظمة الصحيحة أو الخاطئة، والأيديولوجيات، والقواعد التي أنتجتها هنا وهناك في سياق التطورات الاجتماعية، وقد شغلنا ذلك طوال قرن كامل. في النهاية، لم نكسب شيئًا، لكن بريطانيا وألمانيا وأمريكا، التي كانت تدرك جيدًا كيفية استخدام الدين كأداة سياسية منذ تجاربها التبشيرية، ”استخدمته“ للأسف ضدنا، وطوال فترة الحرب الباردة، ضد روسيا. كان الغربيون يتبعون سياستهم بالضبط في ”السياق“ الذي تسميه ”الإسلاموية“ وتقول إنه ممكن على المدى المتوسط والطويل – حتى لو أغضب ذلك بريطانيا. في ذلك الوقت، كنا عالقين بين مأزق ”كيف نهرب من الإسلام ونصبح ’غربيين‘“ و”كيف نهرب من التغريب ونصبح مسلمين أفضل“. لا أعرف، بعد كل هذه التجربة، ما إذا كان الهروب من الإسلام يجعل المرء غير غربي، بل ”كافرًا“ وفقًا للإسلام، و- معذرة – مجرد أحمق وفقًا للغربيين، وما إذا كان الهروب من التغريب يجعل المرء شرقيًا، أو شرق أوسطيًا، أو أورواسيًا، أو شيء من هذا القبيل، وأن الإسلام الأفضل ممكن فقط إذا، بغض النظر عن الدوافع ”السياسية“، من خلال إعطاء الأولوية لخير الإسلام وعدله، والوقوف إلى جانب المظلومين ضد الظالمين، والابتعاد عن كل أنواع الأفعال الشريرة والضارة.
في الواقع، السيد أكجورا، عندما يتعلق الأمر بهذه القضايا، فإن شعبنا العادي، أي المجتمع، قد وجد طريقة جيدة ولديه مستوى أكثر عقلانية وواقعية من الإدراك. ولكن هناك ارتباك بين أولئك الذين يدعون أنهم يعرفون هذه الأمور أفضل من غيرهم: المثقفون والعلماء والأكاديميون.
حتى في مدارسنا الثانوية، نتعلم القواعد الأساسية للمنطق والفئات والمقترحات والتحقق/التزوير. ومع ذلك، لا نجد أي أثر لذلك في أكثر الناس تعليماً. ونتيجة لذلك، فإن شعبنا يسمي التفاحة تفاحة والكمثرى كمثرى، ويعيش حياة أكثر سلامًا. ومع ذلك، وبفضل هؤلاء المتعجرفين، لا نفتقر إلى سلسلة من الصراعات الزائفة وغير المتوافقة بشكل قاطع، مثل الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين، والأليويين والسنة، والأكراد والأتراك، والمؤيدين للاتحاد الأوروبي والمعارضين له. أرجو ألا يساء فهمي؛ فليس لدي أي نية للعداء تجاه المستنيرين أو المثقفين. أنا أحاول ببساطة أن ألمح إلى أن المرض الذي نعاني منه ليس في النهاية مرضًا اجتماعيًا ويمكن علاجه لأنه موجود فقط على مستوى النخبة. لو أن أحد الصراعات التي عشناها في الخمسين عاماً الماضية كان قد نشأ في المجتمع، أعتقد أننا ربما لم نكن لنملك دولة تسمى تركيا بعد الآن! يقول المفكر العربي المولد عبد الله لاروي: “في الماضي، كنا نملي على المجتمعات، بصفتنا أيديولوجيين وعلماء اجتماع، كيف يجب أن تعيش وماذا يجب أن تفعل. الآن نحاول فهم المجتمعات واستنتاج ما يجب أن نفعله”. لذلك، يجب علينا أيضًا التخلي عن عادة دفع ثمن الأجندات الزائفة للنخب المنفصلة عن المجتمع والتي تحاول تشكيله.
السيد أكجورا،
عند تحليل الأنماط الثلاثة للسياسة في بداية القرن الماضي، تنتقد أولاً ”العثمانية“. باعتبارها سياسة فترة التانزيمات، كانت العثمانية، حسب رأيك، ”الحفاظ على الحدود القديمة من خلال إنشاء أمة مثل الأمة الأمريكية“. تذكر أن هذه السياسة نشأت في عهد محمود الثاني، ونفذها علي وفؤاد باشا، واستندت إلى فهم الثورة الفرنسية للأمة والدعم السياسي لنابليون الثالث. بعد انتصار بروسيا في الحرب الفرنسية البروسية 1870-1871، برز مفهوم القومية على النمط الألماني القائم على العرق، وفقد النموذج الفرنسي نفوذه في هذه الاستراتيجية السياسية. تسجل اغتيال ميدات باشا باعتباره التاريخ الذي تم فيه التخلي عن العثمانية.
منذ هذا التاريخ فصاعدًا، دخلت الإسلاموية، التي بدأت فعليًا في عهد عبد العزيز وطبقها عبد الحميد الثاني، حيز التنفيذ كنمط ثانٍ من أنماط السياسة. هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى كسر النفوذ البريطاني بدعم سياسي من فيلهلم الثاني، تبنتها أيضًا حركة الشباب العثمانيين، التي انطلقت بفكرة العثمانية. تؤكد أن هذه السياسة أدت إلى تفاقم المشاعر المعادية لتركيا في أوروبا وشجعت العناصر غير المسلمة داخل الإمبراطورية على السعي إلى الانفصال. ومع ذلك، تضيف أن الإسلاموية كانت لا تزال سياسة حقيقية يمكن تحقيقها على المدى الطويل.
ثالثًا، تحلل القومية التركية، التي تقول إنها لا تزال مجرد ”فكرة“، وتشير إلى أن هذه السياسة قد برزت مع تحسن العلاقات مع الألمان. تعبر عن ميله الشخصي نحو التركية، حتى لو كان ذلك يغضب روسيا، وتختتم مقالته في النهاية بالقول إن علينا الاختيار بين الإسلاموية والتركية.
في هذه الصورة التي ترسمها، من حيث السياسة الخارجية، كانت الإمبراطورية العثمانية تنظر إلى بريطانيا على أنها تهديد خفي طوال القرن التاسع عشر. ثم، عندما تحالفت فرنسا مع بريطانيا ضد ألمانيا الصاعدة، تحولت الإمبراطورية العثمانية نحو المحور الألماني ضدهما. يتضح ضمناً أن روسيا، باعتبارها عدواً أبدياً، يمكن أن توازنها ألمانيا. في هذه الحالة، تصبح الأهمية الاستراتيجية لسياسات الإسلاموية والتركوية التي كانت موجودة طوال الحربين العالميتين الأولى والثانية أكثر وضوحاً. بعد الحرب العالمية الثانية، كما هو معروف، انتقلت ملكية هاتين السياستين إلى أمريكا، وتحولت أهدافهما نحو روسيا.
ولا داعي للذكر أن هذه السياسات، التي وجدتها قابلة للتطبيق، جُربت للمرة الأخيرة بعد تاريخ كتابة المقال — 1904 — من قبل لجنة الاتحاد والتقدم، وانتهت بالفشل. تلك الفترة العظيمة من العمل، التي تضمنت إشعال النار في المستعمرات البريطانية بانتفاضات إسلامية من خلال المنظمة الخاصة، انتهت بخيانة شريف حسين. أدى تغيير سياسة روسيا البلشفية بعد اتفاقها مع بريطانيا في عام 1921 إلى إنهاء محاولة إنفر باشا لإثارة توران. ما زلنا غير قادرين على التخلص من صدمة وغضب هاتين الخيبتين في بداية القرن الماضي على مستوى الدولة.
ونتيجة لهذه الخيبة، شكّل مصطفى كمال الجمهورية على أساس أكثر واقعية، ضمن حدودنا الحالية، على مسار مختلف. تم إزالة الإسلام والتركية من كونهما ورقة في السياسة الخارجية، وأعيد تفسيرهما بالكامل في سياق مختلف، و”أخفيهما“ داخل الجمهورية الجديدة. كما تم اتخاذ تدابير لمنعهما من أن يصبحا جزءًا من سياسات العالم الخارجي الموجهة نحونا، وتم التخلي عنهما ”مؤقتًا“. ونتيجة لذلك، أصبحت الأنماط الثلاثة للسياسة باطلة وتم التغلب عليها، ولكنها أعيد تفسيرها داخل الحدود والنظام الجديدين وأصبحت بمثابة اللحام الذي يربط الأمة الجديدة.
عندما اختفت خطوط المقاومة الأخيرة في عملية تراجعنا العظيمة والمأساوية، لم يبقَ سوى سياسة التغريب، التي استمرت في الواقع كسياسة أمنية على مستوى آخر. تولت هذه السياسة مهمة التعافي من أسلافها وتركت بصمتها على العقد الأول من عمر الجمهورية. لكن في السنوات اللاحقة، تحولت إلى نوع من التانزيماتية ونُفذت بطريقة تقوض دينامياتنا الخفية، كوسيلة لتغيير الهوية والحضارة.
مع اقتراب القرن العشرين من نهايته، نرى الآن أن سياسة التغريب هذه قد انتهت أيضًا. ليس لأن مسارًا آخر قد تم اتباعه، ولكن لأن التغريب قد وصل إلى نهايته المنطقية وحقق غرضه. هل كانت ناجحة؟ بالطبع لا. لأن التفاحة لا يمكن أن تتحول إلى كمثرى. في النهاية، تلاشى التغريب بهدوء من الأجندة، تاركًا وراءه مشاكل وصعوبات جديدة. من هذا المنطلق، لم يعد من الممكن الحديث عن التغريب ككل. ومع ذلك، يبدو أن التغريب سيبقى على جدول أعمالنا في سياق جهود التحول الأكثر جوهرية مثل التحديث، والتكامل الاقتصادي والسياسي مثل الاتحاد الأوروبي، والسياسات العسكرية والسياسية بالوكالة مثل الأمريكية.
هذه النقطة مهمة، لأن نهاية العملية التي بدأت مع الجمهورية، أي الصورة المصطنعة التي خلقها التغريب لتحل محل الأساليب السياسية السابقة، قد اختفت، ونحن الآن عدنا إلى حيث كنا قبل قرن من الزمان! كأمة، كدولة، كدولة، ماذا ستكون استراتيجيتنا السياسية من الآن فصاعدًا، وكيف سيتم تشكيل نظامنا الاقتصادي والسياسي وفقًا لذلك؟ ما هو طريقنا، اتجاهنا، مسارنا؟ إلى أين نحن ذاهبون ولماذا؟ السؤال مطروح أمامنا مرة أخرى، في انتظار إجابة.
السيد أكجورا،
في هذا المفترق الجديد الذي وصلنا إليه، تمامًا كما في عصرك، يبدو أن لدينا مرة أخرى ثلاثة خيارات رئيسية:
1) القومية: هذا الخيار، مثله مثل العثمانية في عهدك، يتكون أساسًا من الحفاظ على الوضع الراهن والرد على أي أفكار جديدة أو بديلة. ويمثله حاليًا فصيلان: اليساريون الكماليون والقوميون الأتراك. يعبر الفصيل الكمالي اليساري عن نوع من عبادة الوضع الراهن، وهو معادٍ للعولمة خارجياً ودوغمائي وشمولي داخلياً. وهو غير متوافق مع العديد من شرائح المجتمع، وكونه مزوداً بالدروع الرسمية لسلطة الدولة، فإنه يتصرف في بعض الأحيان بعدوانية. وهي تدافع عن خط أيديولوجي مغلق أمام أي محاولة للإقناع أو الحوار.
من ناحية أخرى، تحاول الفصيلة التركية إعادة إنتاج التبعية والعادات المتبقية من حقبة الحرب الباردة. داخليًا، من جعل السومريين أوائل الأتراك إلى خطاب ”كارت-كورت“، يبدو أنه غير مدرك أن كل هذه الأطروحات المعروفة ومستواها الفكري هي إحدى العقبات التي تحول دون عملية حقيقية لبناء الأمة والوطنية. في الخارج، تمامًا كما في عصركم، تتبنى شكلاً من أشكال الأوراسية يمكن تفسيره على أنه أيديولوجية وكيلة للمحور الأمريكي-البريطاني في آسيا الوسطى.
في نهاية المطاف، القومية، بفصائلها، ليست خيارًا إيجابيًا بقدر ما هي مغامرة خطيرة وحروب بالوكالة وديناميات صراع لكل من الداخل ومحيطنا المباشر. علاوة على ذلك، من المشكوك فيه للغاية ما إذا كانت قومية حقًا، نظرًا لموقفها من الصراع المستمر حول ”الأمة“ على أساس الدين أو العرق، وما إذا كانت أوروبية آسيوية حقًا، نظرًا لمنظورها في تعريف أوراسيا من وجهة نظر أطلسية. هذا الخيار ليس بديلاً لبلدنا بقدر ما هو مانع يعيق ويقوض البدائل الحقيقية. أعتقد أن هذا الطريق لا يؤدي إلا إلى الفاشية.
2) الأوروبية: على الرغم من أن هذه السياسة تحمل ادعاء ورغبة في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها خيار عملي آخر يتخذ مهام ومعاني أخرى مع تضاؤل احتمالية هذا الانضمام. تبرز ثلاث فصائل داخلها. الأولى تتكون من أولئك الذين يعملون في مهمة بوصفهم لوبي أوروبا في تركيا. والثانية تتكون من أولئك الذين يفضلون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كعنصر غير مباشر في الجهود الرامية إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي، أو في حالة فشل ذلك، محاصرة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب محور الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل. وهذه هي الفصيلة الأكثر تشددًا وتهورًا في الأوروبية. ثالثاً، هناك من هم خارج هذه المعادلات السياسية ويبدون متحمسين للانخراط فيها، وهم يتألفون من ليبراليين ويساريين وأكراد ساذجين يعتقدون أن ”انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي سيخلصنا من البيروقراطية العسكرية والمدنية والرؤساء، وسيمنحنا حقوق الإنسان والمال“.
يتم تقديم الأوروبية، على الرغم من أنها ليست بديلاً جاداً بالنسبة لنا، كما لو كانت الخيار الجاد الوحيد تقريباً، بأسلوب سياسي صاخب للغاية. إنها تتعلق أساساً بمماطلة تركيا، ومضي الوقت، وإظهار صورة جيدة للآخرين، وتغيير القوانين في البرلمان. في رأيي، حتى لو قبلوا بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يوماً ما، فإن الأوروبية هي أسلوب سياسي يتطلب قدراً كبيراً من انعدام الكرامة والشخصية للدفاع عنه، وهي ليست أكثر من نوع جديد من التانزيماتية. من المحتمل أن يؤدي هذا المسار إلى عملية جديدة من التصفية والتفكك.
3) الأوراسية: أولاً، يجب أن أشير إلى أن الأوراسية تعني بالنسبة للجناح اليساري الكمالي من القوميين التعاون الذي أقامه م. كمال مع روسيا لموازنة النفوذ البريطاني. بينما يدافع الأتراك – ربما لأنهم يخجلون من قول توران – عنها باعتبارها الأوروبية الآسيوية الأمريكية لبريجنسكي للتعبير عن وحدتهم الخيالية في آسيا الوسطى. يبدو أن هذه الديماغوجية الأوراسية تهدف إلى إخفاء التوجه المؤيد لأمريكا والتعبير عن موقف معادٍ لأوروبا بطريقة أكثر دقة. لا أعتقد أن تركيا ستكون لها أي علاقة بالأوراسية بهذا المعنى.
السيد أكجورا، أوروبا لدينا، أوراسيا لدينا، أي رؤيتنا الخارجية المتمركزة حول تركيا، تمثل في نهاية المطاف أوسع حدود الإمبراطوريتين العثمانية والسلجوقية، جيوسياسياً وجيوثقافياً. مرة أخرى، هذا يتطلب سياسة عثمانية مفتوحة ومتسقة تجاه هذه الحدود. (في هذا السياق، الإمبراطورية العثمانية ماتت الآن كسلالة وككيان سياسي وما إلى ذلك، لكنها لا تزال حية كتراكم تاريخي وتجربة، أي بمعنى أنها موطن طبيعي وأفق سياسي حقيقي. التاريخ لا يعود إلى الحياة، ولكنه لا يختفي أيضًا!) وبالطبع، يشمل ذلك أيضًا عملية جديدة لبناء الأمة، حيث يُنظر إلى جميع العناصر الموجودة داخلها، مثل الأتراك والأكراد والشركس والألبان والعرب والبوسنيين والجورجيين، إلخ، على أنها مكونات لأمة واحدة. يمكن للشعوب غير المسلمة المتبقية من العصر العثماني أن تكون جزءًا من هذا المزيج، ومكونًا منه، وحليفًا له، إذا رغبت في ذلك. على الصعيد الخارجي، ترى تركيا أن العلاقات المتكاملة والمتزامنة مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، وخاصة مع جيرانها المقربين، هي أساس سياستها الخارجية.
يشمل أفق السلام العثماني استمرارية خط تحديث أكثر أصالة ووطنية مقارنة بعصر التانزيمات العثماني القديم، واستعادة شكل الدولة القديم على أساس حديث وديمقراطي بالضرورة، أي على أساس مبادئ الإرادة الوطنية والعدالة والحرية، وبالتالي إعادة ترسيخ نفسه كموقف مناهض للعولمة. من ناحية أخرى، إلى جانب موقفها الطبيعي المتمثل في حماية العالم الإسلامي والشعوب الشرقية الأخرى، فإنها تمثل أيضًا عولمة بديلة منفتحة على ضمير الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
بعبارة أخرى، إنها سياسة متناغمة قادرة على إجراء تمييزات وتعديلات متوازنة بين وحدة العقيدة واللغة والعاطفة، وواقع السياسة الحقيقية و”إمكانياتها“.
إنه اسم توحيد سيجمع كل الأعراق والطوائف والديانات المتعددة من أدرنة إلى كارس في أمة واحدة، استعادة فخورة ونبيلة ستكون منارة وشعلة لكل المضطهدين في العالم، من غابات المكسيك إلى الفلبين.
أفقنا العالمي. السيد أكجورا، كما تعلم، عندما كتبت ”ثلاثة أنماط من السياسة“، كانت خطى الحرب الإمبريالية الكبرى تقترب، وكانت النخبة المتدهورة في الإمبراطورية العثمانية مشغولة بإنقاذ الموقف وملء جيوبها.
اليوم، هناك حروب قذرة تدعمها الغرب وتحتدم على ”أراضينا“، والجميع يعلم أن عواقبها ستكون أكثر رعباً. مرة أخرى، نواجه خطر فقدان ما لدينا. لكننا لم نعد قادرين على تجنب مواجهة أنفسنا. كان لدينا دولة على خلاف مع شعبها، ونخب فاسدة، ومثقفون فقدوا الأمل في بلدهم، وأمة عاجزة غير متأكدة من مستقبلها. لقد كنا ندور في حلقة مفرغة لمدة مائة عام، والآن نواجه ثلاثة أنماط جديدة من السياسة. هذه المرة، قد ندفع ثمناً باهظاً لتحالفنا مع الغرب.
هل تصدق ذلك، سيد أكجورا، أن العديد من الأشخاص العقلاء نظروا إلى هذا الوضع وقالوا: ”هذا البلد انتهى“، ”لقد خسرنا“، ”نحن مرهقون“. قالوا: ”كل هذا الفساد والفجور والتهور لن يؤدي إلى أي شيء جيد“. لكننا نقول ”المثابرة“، نقول ”لنكن واضحين في طريقنا“، نقول ”لنثق بأنفسنا“. نقول ”هذه الأمة أعظم من أولئك الذين هزموها“. نقول ”هذا البلد سيجد حتماً طريقه“. نقول ”الوطن والحرية معاً“. باختصار، نقول ”الله أكبر“…
وداعًا…
* Üç Tarz-ı Siyaset (ثلاثة أنماط من السياسة)، يوسف أكجورا، مطبعة الجمعية التاريخية التركية، أنقرة، 1976
المصدر: رسائل مفتوحة، أحمد أوزكان، دار نشر يارين، اسطنبول، 2008