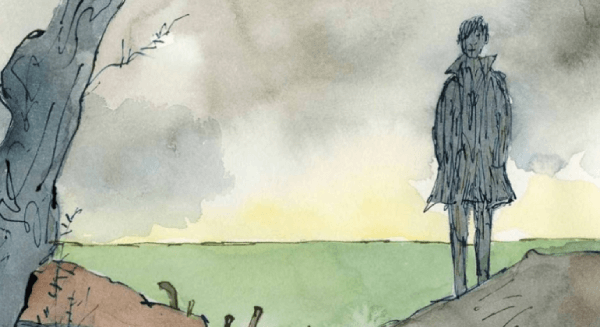لتوضيح العلاقة بين الدولة وسيكولوجية الفرد بشكل أكثر وضوحًا، دعونا نسلك مسارًا جديدًا، هذه المرة من خلال مفهومي السلطة ومعاداة السلطة.
ما هي السلطة؟
هانز جورج غادامير، تلميذ هايدغر، لا يهتم فقط بالمشكلات الناتجة عن عقلانية الحداثة العملية التي دفعت الأخلاق والسياسة إلى الخلفية. بل يطور أطروحات هايدغر حول الدائرة التأويلية وحتمية التقاليد إلى درجة أنه، تحت عنوان “تأويلية التقاليد”، يتبنى موقفًا يشرعن الأحكام المسبقة والسلطة، مما جعله يتعرض لاتهامات من قبيل “الرجعي المعادي للتنوير والعلم”. ومع ذلك، فإن قراءة متأنية لـ غادامير ستكشف بسهولة الظلم الذي يتعرض له في هذه الاتهامات. لكن عندما يقول إن “التاريخ ليس ملكًا لنا، بل نحن ملك له. قبل أن نفهم أنفسنا من خلال عملية التأمل الذاتي، نفهم أنفسنا بوضوح في إطار العائلة والمجتمع والدولة التي نعيش فيها. إدراك الفرد لذاته يتردد في الدائرة المفرغة للحياة التاريخية”، فإنه لا يخفي أن مواده المفاهيمية واللغوية مستمدة من الإطار المنهجي لهيغل.
غادامير يشرعن ليس فقط الوعي التاريخي والتقاليد، بل أيضًا السلطة والدولة. رغم أنه لا ينكر صلته بإرث هيغل، إلا أن عدم اهتمامه المكثف بفلسفة السياسة جعله لا يركز بشكل كافٍ على تشابهه مع رؤية هيغل للدولة، مما حد من قدرتنا على الاستفادة منه في فهم العلاقة بين “العقل العملي” والدولة. ومع ذلك، فإن الصلة بين أرسطو، الذي يعتبر مصدر الأخلاق في العقل العملي ويصف الإنسان بأنه “حيوان سياسي”، وهيغل، الذي يجذر الدولة في “الأخلاق الموضوعية” (Sittlichkeit) ويرى “الجمهورية المتحضرة”، لا تخفى على المطلعين. إذا ركزنا على هذه النقاط، يمكن لـ غادامير أن يلقي مزيدًا من الضوء على فهمنا لعلاقة الدولة بسيكولوجيا الفرد.
ما يجعل غادامير يدافع عن السلطة والدولة في تأويلية التقاليد هو تمييزه بين “السلطة” و”الاستبداد” والطاعة العمياء. وفقًا لـ غادامير، جوهر السلطة لا يقوم على القمع أو العدوان أو الطاعة العمياء، بل على الاعتراف بأن الآخر متفوق في الحكم ويتقدم عليك. السلطة لا تُمنح، بل تُكتسب من خلال الحوار وتستند إلى الاعتراف وليس الطاعة؛ ولا يمكن أن تكون غير عقلانية أو تعسفية. في تأويلية التقاليد، يركز غادامير أولًا على بنية الفهم وأولوية الممارسة، ثم يربط حتمية الأحكام المسبقة بشرعنة السلطة، ومن هناك يتجه لربط السلطة بالتقاليد. تقاليدنا وعاداتنا، حتى لو لم تُسمى صراحة، تمتلك سلطة. قوتها في تشكيل مواقفنا وسلوكياتنا لا تقتصر على تكوين أساسنا فحسب، بل تنتقل أيضًا إلى الأجيال القادمة. إنها تحدد سلوكياتنا ومواقفنا إلى حد كبير خارج معايير العقل. الحفاظ على التقاليد، بقدر ما يعتمد على الاختيار الحر للفرد مثل الثورة والابتكار، يرتبط بالعقل كعنصر من التاريخ والحرية.
من كل هذا، بالإضافة إلى كون السلوك السياسي والأخلاقي (العقل العملي) أرضية مشتركة بين الدولة وسيكولوجية الفرد، نستنتج أن كل أشكال السلطة، بما فيها سلطة الدولة، تعتمد على اعتراف الفرد واختياره العقلاني. لا يمكن لأي سلطة أن تستمر في الوجود بشكل دائم من خلال القمع أو الهيمنة أو التلاعب على الآخرين. حتى السلطات التي تختار الاستبداد كطريقة للوجود لا تقصر إلا عمر سلطتها. لأن كرامة الإنسان كانت دائمًا قادرة على هزم التعذيب؛ لا يمكنك أن تشكل حلاً جديدًا ودائمًا لمشكلة “الحياة الجيدة” عبر القمع والهيمنة. أولئك الذين يدعون ذلك يجب أن يتأملوا بعمق في المادة البشرية التي يعتمدون عليها والعالَم الذي يسعون لبنائه.
في بعض الأحيان، في بيئات العنف الصريح، قد يختار الفرد طريقًا نفسيًا للدفاع عن نفسه مثل التماهي مع المعتدي، لكن هذا وضع جزئي وعابر في سيكولوجية البالغين، حيث يتم استعادة الذات (self) عند أول فرصة. أما أولئك الذين يتعرضون لبيئات عنف منذ الطفولة المبكرة، فيطورون أمراضًا نفسية أكثر استدامة، بما في ذلك بنيات الشخصية الاستبدادية. غالبًا ما يخرج الطغاة الجدد من هؤلاء الذين نشأوا في هذه البيئات القاسية. لكن لا يمكننا تعميم هذه الحالات الاستثنائية على مفهوم السلطة كحالة إنسانية عامة.
السلطة ترتبط مباشرة بالسلطة والمكانة الناتجة عن الفكر والمعرفة وخبرة الحياة. في العديد من اللغات، يشترك مصطلح “السلطة” مع “المؤلف” في الأصل الاشتقاقي، لأن كلاهما يعكس مفهوم الخلق والابتكار. في كل “حوار”، هناك سلطة، سواء كانت ظاهرة أو خفية. السلطة لا تُفرض في الحوار، بل تُظهر نفسها. “إرادة القوة” التي اعتقد نيتشه أنه اكتشفها هي شكل منحرف من السلطة، لأنه لم يتم بعد إقامة حوار أو تحقيق سلطة، والأطراف يصبون إمكاناتهم على بعضهم البعض دون تردد في استخدام القوة. حتى يتم إقامة الحوار وتحقيق السلطة… حتى “بيئة التواصل المثالية” لهابرماس يمكن اعتبارها اقتراحًا حول كيفية تحقيق السلطة، وليس إلغاءها.
الدولة هي السلطة العامة التي ينتجها المجتمع، بما في ذلك الحق الحصري في استخدام القوة بشكل مشروع؛ وهي دليل على أن المجتمع يمتلك حوارًا عامًا خاصًا به، وهي العقل العملي الذي يقره المجتمع. لهذا نقول: “تُحكمون بالطريقة التي تستحقهونها” أو “هذه دولتكم”. “السياسة والأخلاق” يجب أن تُفهم في هذا السياق كطرق لتحقيق الحوار والسلطة في المجال العام.
باختصار:
- الأرضية المشتركة التي تربط بين الدولة وسيكولوجية الفرد هي السياسة والأخلاق. كل من الدولة والفرد يعتمدان في أنشطتهما على “العقل العملي”، مع مراعاة “الآخر” و”العلاقة”.
- السلطة هي نتيجة مباشرة للحوار؛ كل حوار يحتوي على سلطة، لكنها تُكتسب من خلال الاعتراف وليس القمع، ولا يمكن استخدامها بشكل غير عقلاني أو تعسفي.
- شرعية الأنشطة السياسية للدولة كسلطة متجذرة في “الأخلاق الموضوعية” للمجتمع وأسلوب حواره العام. هذا التبرير ليس تلاعبًا أيديولوجيًا من قبل الدولة، بل على العكس، يجب على الدولة أن تعدل نفسها وفقًا لاعتراف المجتمع.
ما هو معاداة السلطة؟
بالطبع، هناك العديد من النقاط التي يتركها هذا المنظور حول السلطة والدولة مفتوحةً. من أهمها: “أجهزة الدولة القمعية والإيديولوجية” والمبادرات المعارضة للدولة؛ “إذا كانت الدولة تستند إلى مثل هذه الأسس الوجودية والعقلانية، وحتى أكثر أشكال الحكم قمعًا تُعتبر شرعيةً من قِبَل “الأخلاق الموضوعية” للمجتمع، فلماذا تلجأ إلى إنتاج القمع والإيديولوجيا لضمان بقائها؟ ولماذا، رغم هذه الأسس الواضحة، يقدم البعض على مبادرات معارضة للدولة؟”. الإجابات التي تعتمد على “المؤامرات الخارجية” تجعل الناس عادةً “يمينيين”، بينما تلك التي تنكر “الخصائص الهيكلية للمجتمع والدولة” تجعلهم عادةً “يساريين”. نحن، من جانبنا، نأخذ بالإجابات “اليمينية” و”اليسارية”، لكننا نعتقد أنها غير كافية. نرى أن هذه الفجوات ناتجة عن عدم أخذ المنظور السابق (الذي قدمناه) بالاعتبار بشكل كافٍ الأبعاد غير العقلانية للوجود والعلاقات الإنسانية. إذا تم سد هذه الثغرات عبر “نقد الإيديولوجيا” والإمكانيات التي توفرها السيكولوجيا الفردية والاجتماعية، فلن تبقى مشاكل كبيرة في رأينا.
يحمل الوجود الإنساني إمكانيات إيجابية مثل العقل والأخلاق، لكنه في البداية (وفي الوقت نفسه) غير عقلاني. جميع أشكال العقلانية تنبت من تربة اللاعقلانية. سبب عدم عقلانية الإنسان في البداية هو أن العقلانية تتطلب تطورًا عصبيًا نفسيًا واجتماعيًا معينًا. إن كون الإنسان عقلانيًا وغير عقلاني في آنٍ واحد يرجع إلى كونه “كائنًا راغبًا”، سواء سمينا ذلك غريزةً أو دافعًا.
السلطة، التي ربطناها أعلاه بالعقل العملي (السياسة والأخلاق)، تنشأ في الأصل من الجوانب غير العقلانية للإنسان. أهم فرق بين الإنسان والكائنات الأخرى هو اضطراره إلى مرور بطفولة طويلة. الطفولة الطويلة تعني فترة اعتماد طويلة. جذور قبولنا الأول للسلطة تكمن في تجربة الطفولة الطويلة الحتمية. حقيقة أننا لن نستمر في الوجود دون آخرين يعتنون بنا بشكل أفضل مما نستطيع، تُنقش في نفسنا إلى الأبد. نختبر امتنانًا لوجود السلطة منذ أول حوار لنا. في هذا السياق، يبدو أكثر ملاءمةً أن نربط السلطة نفسيًا بـ”الأم” بدلًا من “الأب” الذي يُعتبر دائمًا “الثالث” الذي يعيق الاندماج. دراسات “الأنا العليا” (superego) تظهر أن علاماتها الأولى تظهر في مراحل الطفولة المبكرة، أبكر بكثير مما اعتقد فرويد. “الأم الجيدة بما يكفي”، التي نسلم أنفسها إلى ذراعيها الآمنتين، سواء أردنا ذلك أم لا، هي مصدر الصورة الإيجابية للسلطة والدولة في داخلنا. بينما خيبات الأمل الحتمية في علاقتنا بالأم هي مصدر الصورة السلبية للسلطة والدولة.
هذه الثنائية تستمر طوال حياتنا اللاحقة: “الجيد” هو ما يثير إعجابنا ويسمح لنا بالاندماج مع الآخر ويُلبي احتياجاتنا، بينما “السيء” هو ما يخيب آمالنا ويجعلنا نشعر بالوحدة والعجز. ما يحدد تجربتنا مع السلطة وكيف نتفاعل معها هو هذه الصورة العامة للسلطة، المكونة من مزيج “الجيد” و”السيء”. الجوانب “الجيدة” و”السيئة” في الصورة العامة للسلطة هي القوة الدافعة لـ”معاداة السلطة” في داخلنا؛ عندما نواجه مواقف غير مقبولة من السلطة أو الدولة، يتم تحفيز هذه الجوانب، ويتحول الاعتراف إلى نقد وتمرد. الأفراد في الحركات المعارضة إما يرفضون السلطة لأنها لا تتوافق مع الجوانب “الجيدة” في تصورهم، أو لأنها تستحضر الجوانب “السيئة”.
بسبب الارتباط المباشر بين الصورة العامة للسلطة وممارسات التربية و”الأمومة” في المجتمع، نرى أن تسمية الدولة بـ”الأم” أكثر ملاءمة. هذه التسمية تفسر بشكل جيد المشاعر والمواقف المزدوجة التي تم الكشف عنها في الدراسات النفسية الفردية والاجتماعية حول السلطة.
إذا نظرنا إلى حركة الرغبة وليس محتواها، استنادًا إلى المعرفة التجريبية من تجارب العلاج النفسي الجماعي، يمكننا القول – فيما يخص السلطة ومعاداة السلطة – إن الرغبة الإنسانية تتأرجح بين الحاجة إلى ثقافة مشتركة والخوف من فقدان الاستقلالية الفردية داخل المجموعة، أي بين الحرية والتضامن. هذا التأرجح هو سبب آخر لموقفنا المزدوج تجاه السلطة. أحيانًا نطلب من السلطة حماية الثقافة المشتركة، وأحيانًا حماية الاستقلالية الفردية؛ بالمثل، قد نعارض السلطة أحيانًا دفاعًا عن الثقافة المشتركة، وأحيانًا دفاعًا عن الاستقلال الفردي.
خلاصة القول؛ تمتلك الدولة جذورا عميقة في أخلاق المجتمع وفي الطبيعة الحوارية للعلاقات الإنسانية، لكن من الصحيح أيضًا أن هناك جذورًا نفسية فردية واجتماعية بنفس العمق لمعارضة سلطتها. هذه الطبيعة المزدوجة لنفسية الإنسان تدفع الدولة إلى ردود فعل دفاعية وصراع إيديولوجي من أجل “البقاء”. رد فعل الدولة الدفاعي وصراعها من أجل البقاء، باعتبارها السلطة الوحيدة الشرعية في استخدام القوة، مفهوم إلى حد ما. لكن عندما تصبح ردود الفعل الدفاعية والصراع الإيديولوجي للبقاء المجال الرئيسي لنشاط الدولة، فهذا يعني أن “حد المعقولية” قد تم تجاوزه، وتحولت السلطة إلى استبداد. رغم أن هذا ليس السبب الأصلي لوجود الدولة، إلا أن أولئك الذين يخوضون صراع “معاداة السلطة” سيبدأون في رؤيتها حتمًا على أنها “الطرف الآخر في الحرب”. لكن إذا كان المجتمع لا يزال يستحق أن يُحكم بدولة، وإذا كان يمتلك الأسس الأخلاقية والسياسية لذلك، فبغض النظر عن نتيجة الحرب، سينتهي الاستبداد عاجلًا أم آجلًا، وستظهر الدولة مرة أخرى في الأفق كسلطة شرعية.