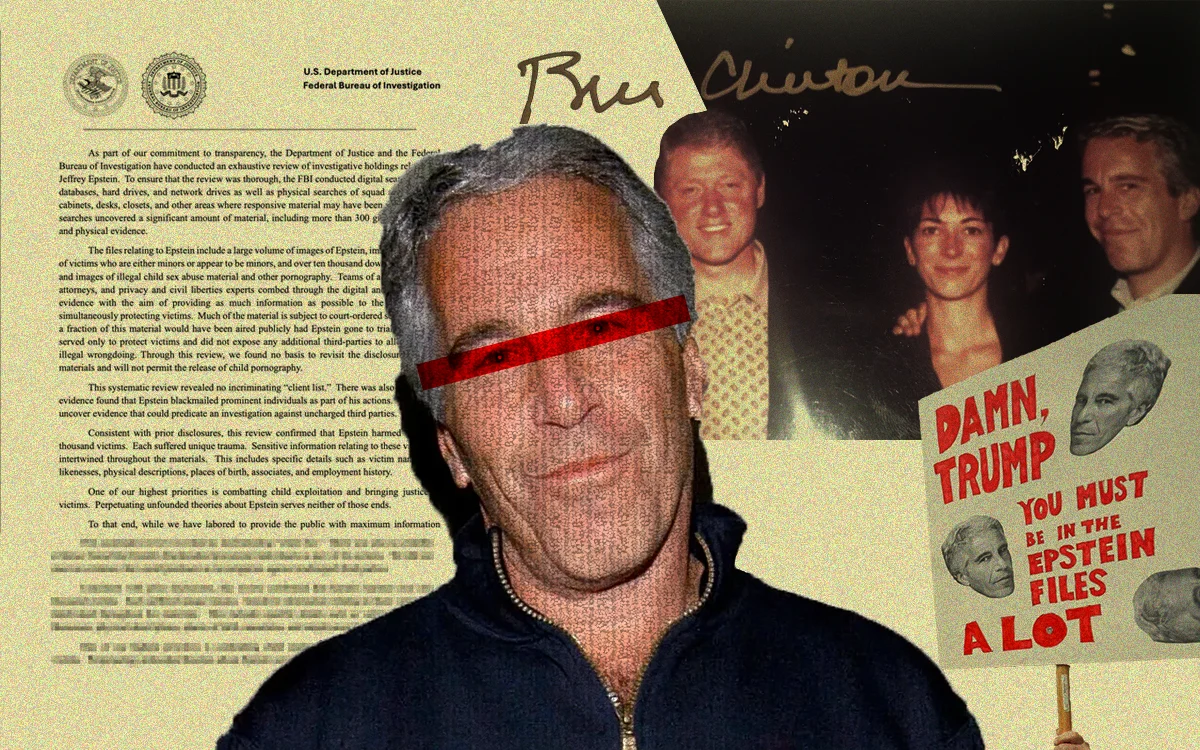كيف يجب أن نفهم قضية إبستين، التي أثارت جدلاً وغضباً فوريين عند ظهورها؟ هل هذه القضية استثناء لم يتوقعه الغرب، شذوذ في الروايات الكبرى ووعود الحداثة، حالة غير طبيعية في عالم يحكمه أسلوب الحياة النيوليبرالي؟ إلى جانب التفوق المادي الواضح للغرب – طرقه المنظمة وشوارعه النظيفة وأكاديمياته المتقدمة وأنظمته المالية الكبيرة – فإن تاريخه القريب والبعيد هو في الواقع عالم أصبحت فيه الاستثناءات الأخلاقية هي القاعدة. المحرقة هي استثناء، والمذبحة البوسنية هي استثناء، وإساءة معاملة الأطفال في الكنائس، التي أصبحت الآن عادة، هي استثناء، وحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال المنظمة والمنهجية، التي أصبحت حتى موضوعًا سينمائيًا، هي استثناء، وغزو العراق هو استثناء. الإبادة الجماعية في غزة استثناء، ولكن مع مرور الوقت يتضح أن هذه الأمور هي في الواقع القاعدة نفسها. والآن، تُعرض قضية إبستين أيضًا للوهلة الأولى على أنها انحراف إجرامي في العالم المعاصر، أو ”شذوذ“ منعزل نتج عن الرأسمالية المتأخرة، أو قصة استثنائية لشخصية ”مرضية“ تسللت إلى دوائر السلطة العليا. أنا أزعم أن قضية إبستين ليست استثناءً، مرضية أو شاذة، بل هي الطابع الحقيقي للرأسمالية، والنتيجة الطبيعية للسلطة المفرطة، والغاية النهائية لنمط الحياة النيوليبرالي. كيف يمكن للأشخاص الفاضلين أن يتوقعوا نظامًا أخلاقيًا وعادلًا من الرأسمالية وأسلوب الحياة النيوليبرالي! ومع ذلك، سيتضح بمرور الوقت أن العالم الغربي سيحول هذه القضية إلى استثناء من الحداثة، وشذوذ من النيوليبرالية، وسيقول إنه لا ينبغي النظر إلى الاستثناء بل إلى القاعدة، وليس إلى الشذوذ بل إلى القاعدة. وللقيام بذلك، سيلجأ إلى الأساليب التالية. كما هو الحال مع الهولوكوست، سيحاول إظهار أن هذا الوضع هو انحراف عن الحداثة، ويلقي باللوم كله على جيفري إبستين، ويجعله كبش فداء ويبرئ من حوله. سيذهب إلى أبعد من ذلك، واعتمادًا على علم النفس ما بعد الفرويدي، سيصنف أفعال إبستين ليس على أنها ”لا أخلاقية“ بل على أنها ”مرض“. وبهذه الطريقة، سيتم الحكم على الأفراد وإلقاء اللوم عليهم، ولكن النظام سيتم تطهيره وتبرئته. من خلال وضع هذا الحدث فوق الأحداث الأخرى في الماضي، لن يتمكن من رؤية كيف أن النظام الرأسمالي ككل قد حول العالم إلى جحيم. ستصدق الجماهير الغفيرة، التي يشار إليها باسم ”الشعب“، في نهاية المطاف هذه الخيال المسوق، وستلعن إبستين، ولكنها ستواصل العمل بلا كلل لإنشاء أنظمة إبستين صغيرة أو كبيرة مدفوعة بـ ’الكفاءة‘ و ”الهوس بالربح“ و ”الشهوة للسلطة“.
وبذلك، لن يذكروا اسم إبستين، بل سيكتفون بالقول إنهم يسعون إلى النمو، والتمتع بقوة أكبر، وتحقيق النصر. سيكونون مدركين تمامًا أن الطريقة الوحيدة للنمو، والتمتع بقوة أكبر، وتحقيق النصر هي من خلال المال، لكنهم سيترددون في الاعتراف بذلك لفترة من الوقت. ومع مرور الوقت، سيتعودون على هذا التردد وسيعلنونه ليس كاعتراف بل بفخر. هنا، سأحاول أن أشرح، بالاعتماد بشكل خاص على بعض المنظرين الغربيين، أن قضية إبستين ليست استثناءً للحداثة أو شذوذًا في النيوليبرالية.
في ذلك الوقت، كان للهولوكوست تأثير صادم في أوروبا؛ لم يستطع أحد فهم ما حدث خلال العصر الذهبي للحداثة واعتبره حالة مرضية واستثناءً وشذوذًا في الحداثة. في هذه المرحلة بالذات، جادل زيغمونت باومان، في كتابه الحداثة والمحرقة، بأن المحرقة لم تكن انحرافًا عن الحضارة الحديثة، بل كانت نتيجة طبيعية وحتمية لخصائص الحداثة الأساسية، مثل العقلانية والبيروقراطية والكفاءة التكنولوجية، وأن هذا كان، في الواقع، غاية الحداثة. يعرّف باومان الحداثة بأنها ”بستاني“ يسعى إلى تخليص العالم من الأعشاب الضارة. في هذه العملية، يُنظر إلى بعض الناس على أنهم ”قيّمون“، بينما يُنظر إلى آخرين على أنهم ’نفايات‘ أو ”أعشاب ضارة“. على حد تعبير باومان، يتم اختيار ”النفايات البشرية“ من فئة ”الأعشاب الضارة“. إن تجاهل النظام لهؤلاء الضحايا على المدى الطويل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمكانتهم المتدنية في الحداثة. تمنع البيروقراطية الحديثة الأفراد من الشعور بالمسؤولية الأخلاقية عن طريق تقسيم العمل إلى أجزاء صغيرة. لا يقوم الشخص إلا بالمهمة الفنية الموكلة إليه ولا يواجه رعب النتيجة النهائية. عندما نقرأ قضية إبستين من منظور بومان، نرى أن هذا الحادث ليس ”آلة جريمة“ عشوائية، بل هو وحشية هيكلية مكنها النظام الحديث وسمح بها وأعدها ويسرها. الشبكة التي أنشأها إبستين تستند إلى ”إرضاء ومتعة“ ”النخبة“ على أعلى المستويات (البستانيون). عادة ما يتم اختيار الضحايا من بين الفئات المحرومة اجتماعيًا واقتصاديًا، أولئك الذين تم دفعهم إلى هامش النظام. كانت الشبكة اللوجستية الواسعة حول إبستين (الطيارون والمحامون والمتخصصون في العلاقات العامة والممولون) تعمل بعقلانية بيروقراطية كاملة. كل ترس ”كان يقوم بعمله فقط“. كان المصرفي يدير تحويلات الأموال، والطيار يقود الطائرة. طغت العقلانية الفنية للأفعال على المحتوى الأخلاقي، مما أدى إلى خلق ”عمى“ جماعي.
يقول باومان إن ”العقلانية الآلية“ (السعي إلى تحقيق هدف ما بأكثر الطرق كفاءة) لها الأسبقية على القيم الإنسانية في العصر الحديث. في قضية إبستين، تحولت العلاقات الإنسانية تمامًا إلى ”أدوات“. تم تصنيف الفتيات الصغيرات والأطفال والرجال على أنهم ”سلع“، بينما تم تصنيف العلاقات السياسية والعلمية على أنها ”رأس مال اجتماعي“. يعد استبدال الأخلاق بالكفاءة وتحليل المنفعة أحد النقاط الأكثر أهمية في نقد بومان للحداثة. يصور مفهوم بومان اللاحق ”الحداثة السائلة“ عالماً يتم فيه قطع الروابط ويكون كل شيء مؤقتاً. لقد خلق إبستين ”واحة“ في هذا العالم السائل بفضل قوة المال والعلاقات، فوق الحدود الوطنية والقوانين المحلية والأخلاق التقليدية. لذلك، فإن إبستين ليس ”عيبًا“ في الحداثة؛ كما يحذر باومان، فهو النتيجة المنطقية الأكثر تطرفًا وظلمة التي يمكن أن تحققها العقلانية التقنية غير الأخلاقية ورأس المال غير المحدود. يقول باومان إن الأنظمة الحديثة تجعل الناس ”أديوفوريين“ (بعيدين عن التقييم الأخلاقي). بالنسبة للسياسي أو العالم الذي يستقل طائرة إبستين، يتم تبرير تلك الرحلة على أنها مجرد ”رحلة عمل مثمرة“ أو ”ضرورية لتكوين علاقات قوية“ أو ”وسيلة نقل سريعة“. عندما يتم تقسيم العمل إلى أجزاء، يكون كل جزء (الرحلة، الوجبة، الإقامة) ”تقنيًا خاليًا من العيوب“ في حد ذاته. ويختبئ رعب النظام ككل وراء هذه الأجزاء. قضية إبستين هي ”ثقب أسود“ حيث تلتقي القوة التقنية للحداثة مع رغبة الرأسمالية النهمة في التملك. كما أكد باومان في تحليله للهولوكوست، ”إذا اجتمعت التكنولوجيا اللازمة والبيروقراطية العقلانية واللامبالاة الأخلاقية، يمكن ارتكاب أفظع الفظائع باستخدام أكثر الأساليب ’حداثة‘“. إبستين ليس شذوذاً في الحداثة؛ إنه وحش ”إقطاعي-حديث“ يظهر عندما يتحد رأس المال غير المنظم مع الإمكانيات التكنولوجية. على الرغم من أن الغرب يحاول تغليف هذه القضية وتسويقها على أنها ”استثناء“، إلا أنه في الواقع يواجه نموذجاً عادياً للنظام الذي بنى.
يقدم مارشال بيرمان، في كتابه سياسة الأصالة: الفردية الراديكالية وظهور المجتمع الحديث، الملاحظة التالية أثناء وصفه للمدن التي هي رحم الرأسمالية: ”لتوقع ما سيقال هنا، لا تحتاج إلى معرفة شخصية الشخص، بل اهتماماته فقط.“ في الرأسمالية، لا توجد شخصية، بل اهتمامات فقط. يُبرر الرأسمالية نفسه تاريخياً من خلال مفاهيم الكفاءة والحرية والعقد وعقلانية السوق والاختيار الفردي. المنطق الأساسي للرأسمالية هو أن كل ما يمكن تحويله إلى سلعة يتم تحويله إلى سلعة. من الناحية النظرية، يبدو أن هذا المبدأ يقتصر على قوة العمل، ولكن من الناحية العملية، يصبح الجسد والمتعة والخصوصية والسمعة والأسرار وحتى الجريمة جزءًا من علاقات السوق. يعتبر إبستين وشبكته أحد الأمثلة النموذجية الأكثر إزعاجًا ولكنها غير مفاجئة على هذا الانتهاك. المسألة هنا ليست مجرد جريمة جنسية؛ إنها تحويل الجسد والخصوصية والكرامة الإنسانية إلى أدوات للسلطة ورأس المال. هذا ليس ”أثرًا جانبيًا“ للرأسمالية، بل هو نتاجها المنطقي. مفهوم ماركس عن ”عبادة السلع“ يكتسب معنى جديدًا هنا: لم تعد الأشياء هي وحدها التي تُعبَد، بل الوجود الإنساني نفسه. قضية إبستين هي نتيجة مظلمة ولكنها متسقة وحتمية لهذا العملية. إن إطار عمل فريديريك لوردون السبينوزي-الماركسي مضيء للغاية هنا. وفقًا لوردون، لا يحكم الرأسمالية الناس من خلال الإكراه المادي، بل من خلال إعادة هيكلة رغباتهم. يصبح الناس مرتبطين بالنظام من خلال الرغبات التي يعتقدون أنها رغباتهم الخاصة. هذه هي الآلية التي تعمل في قضية إبستين. رغبات من هم في السلطة لا حدود لها؛ والشعور بالحصانة يجعل الرغبة غير قابلة للسيطرة؛ وتنتج الشبكات الرأسمالية درعًا يحمي هذه الرغبة ويخفيها وينشرها.
لا يسعى الرأسمالية إلى تقييد الرغبة وتداول الغريزة الجنسية واقتصاد المتعة، بل إلى تحفيزها وإغرائها. الرأسمالية لا تفرض محظورات أو قيود؛ بل تظهر طرق تجاوز الحدود. الرأسمالية هي نظام يطلق العنان للرغبة بشكل استراتيجي ويدير/يوجه عواقبها. بهذا المعنى، فإن إبستين ليس أبدًا فقدانًا للسيطرة أو خللًا في الرأسمالية؛ بل على العكس، فهو النتيجة الطبيعية لسياسات وإقتصادات المتعة الرأسمالية. في الرأسمالية، يستند القانون نظريًا إلى مبدأ المساواة، ولكن في الممارسة العملية، يصبح القانون أداة تتواءم وترتخي، بل وتستسلم دون مقاومة، اعتمادًا على درجة القرب من رأس المال. ما نراه في قضية إبستين ليس انهيار القانون، بل كشف وفشل وظيفة القانون القائمة على الطبقية والنخبوية. لذلك، فإن إبستين ليس شخصية ”خارجة عن القانون“. إنه التجسيد الملموس للقانون الغربي الذي يجمل فعلًا مروعًا. إبستين هو في الأساس شخصية نموذجية تكشف عن الأشخاص الذين يمكن تعليق القانون أو تخفيفه أو التلاعب به من أجلهم. الشذوذ في الرأسمالية لا يكمن في عدم عمل القانون. بل هو حقيقة أن القانون يعمل وفقًا لرأس المال. (يشرح كتاب مايكل إي. تيغار، The Rise of Capitalism and the Law، هذه المسألة بدقة من منظور تاريخي). من ناحية أخرى، يزيل الرأسمالية الأخلاق من كونها مبدأ عامًا ويحصرها في نطاق الضمير الفردي. طالما أن النظام يعمل، يتم ترميز التدمير الأخلاقي على أنه ”انحراف شخصي“. قضية إبستين هي أيضاً ضحية لهذا التصنيف. لا يتم تقديم القضية الحقيقية على أنها مشكلة هيكلية ومنهجية تتعلق بالنظام، بل على أنها مسألة تتعلق بـ”فرد غير أخلاقي“. ومع ذلك، فإن الانهيار الأخلاقي هنا ليس فرديًا، بل مؤسسيًا ومنهجيًا. إن التشغيل المنهجي لشبكات الصمت، وسياسة وسائل الإعلام الطويلة الأمد المتمثلة في لعب دور الثلاثة قرود، وآليات الحماية والمحسوبية السياسية والاقتصادية توضح كيف يمكن للرأسمالية أن تعلق الأخلاق بشكل وظيفي وتعسفي. فالرأسمالية ليست مجرد نمط إنتاج، بل نظام رغبة. الأخلاق ليست في صميم النظام الرأسمالي، بل في خطابه. ما يُقدم على أنه استثناءات هو في الغالب أكثر أشكال عمل النظام أصالة. لذلك، فإن الشذوذ الحقيقي لا يكمن في قضية إبستين، بل في العقلية التي تصر على قراءة وفهم هذه القضية على أنها انحراف ”خارج“ الرأسمالية. إبستين ليس حادثًا عرضيًا للرأسمالية، بل هو اسم المنطقة المظلمة التي تتسامح معها القوة الرأسمالية من خلال التستر عليها.
النيوليبرالية أيضًا هي أكثر من مجرد سياسة اقتصادية؛ فهي، على حد تعبير ميشيل فوكو، نظام إضفاء الطابع الذاتي الذي يعيد تعريف الإنسان من الألف إلى الياء. في هذا النظام، يُختزل الإنسان إلى ”رأس مال بشري“ يعمل باستمرار على تحسين نفسه بدلاً من أن يكون فاعلاً أخلاقياً. في مثل هذا العالم، يصبح الجسد والرغبة والعلاقات وحتى الجريمة سلعاً. تتضح أهمية قضية إبستين في هذا السياق الجنائي. لا يقتصر الأمر هنا على الاعتداء الجنسي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تحويل الجسد، وخاصة الأجساد الهشة والضعيفة والعزلاء، والأشخاص العاجزين والمحتاجين، إلى سلعة تتداولها شبكات النخبة العالمية. في هذا النظام، أي شخص يمكن شراؤه بالمال هو سلعة. النظام النيوليبرالي، كما يشير بيونغ-تشول هان، هو هيكل يرفع من شأن الفرد من خلال خطاب الحرية ويضعه في حالة مستمرة من المنافسة والأداء واقتصاد المتعة، ويعمل من خلال الضرورات الداخلية أكثر من الضغوط الخارجية (The Burnout Society، Psychopolitics). في هذا السياق، لا يمثل شخصية إبستين كاريكاتيرًا مبالغًا فيه للفرد النيوليبرالي، بل هو مظهر ضروري للتوسع اللامحدود للرغبة، والاندماج بين الوصول إلى المتعة والمكانة الاجتماعية، والعلاقة التكافلية بين السلطة والحصانة. في النظام الرأسمالي، سيكون من غير الطبيعي ظهور أي شخصية أخرى غير إبستين.
يحتاج النظام إلى كبش فداء ليبرئ نفسه ويطهر نفسه. الكبش الفداء يطهر النظام بينما يدين الأفراد. عند النظر إلى الأمر في سياق نظرية رينيه جيرارد عن الكبش الفداء (bouc émissaire، Scapegoat، Alfa Yayınları 2024)، نرى أن النظام الاجتماعي لا يحل حقًا مشاكل استمراريته وصراعاته الداخلية وتواطؤه الضمني؛ بل من خلال تركيز هذه التوترات على شخصية معينة والقضاء عليها رمزياً. وبهذه الطريقة، تحول المجتمع عبء العنف الجماعي والمسؤولية الأخلاقية إلى كيان واحد، واسم واحد، وقصة واحدة، مما يجعل عيوبه الهيكلية غير مرئية ويُعيد إنتاج وهم البراءة. وفقًا لجيرارد، في أوقات الأزمات، يفضل المجتمع تهدئة الفوضى الناجمة عن الرغبة المقلدة وقمعها وكبحها، ليس من خلال مواجهتها مباشرة، بل من خلال التضحية بها. يتم اختيار كبش الفداء ليس لأنه مذنب، بل لأنه مناسب لتحمل الذنب وإنقاذ النظام. في المجتمعات الحديثة، لا تعمل هذه الآلية في شكل طقوس بدائية، بل من خلال خطاب القانون والإعلام والطب النفسي والأخلاق. كبش الفداء عند جيرارد يطهر رمزياً النظام الاجتماعي من توتراته الداخلية وتواطؤه الجماعي في الجريمة، ليس من خلال المواجهة الهيكلية، بل من خلال التخلص الرمزي من هذا العبء بتركيزه على شخصية واحدة، وبالتالي إعادة بناء روايته الخاصة عن البراءة. في هذه المرحلة، تبدو نظرية كبش الفداء لرينيه جيرارد تفسيرية للغاية من حيث فهم كيفية تداول قضية إبستين اجتماعياً. وفقًا لجيرارد، تجد المجتمعات الراحة من خلال تركيز عنفها الداخلي وتواطؤها على شخصية واحدة، وبالتالي إضفاء الطابع الفردي على الذنب الجماعي وإخفاء المشاكل الهيكلية. إن حقيقة أن الرواية ستتلاشى في نهاية المطاف بعد وفاة إبستين، وستُغلق الملفات، وستُختزل القضية إلى فضيحة أخلاقية، هي حقيقة مهمة في إظهار كيفية عمل هذه النسخة الحديثة من آلية كبش الفداء. ومع ذلك، فإن الجانب المقلق حقًا في قضية إبستين ليس الانحراف الفردي بقدر ما هو حقيقة أن هذا الانحراف ظل مرئيًا ومعروفًا لعقود، لكنه ظل بمنأى عن المساس ولا يمكن إيقافه. هذه الحصانة ليست حالة طوارئ يتم فيها تعليق القانون الحديث؛ بل على العكس، إنها مؤشر على مجال من مجالات السلطة أصبح فيه الاستثنائي هو القاعدة، كما تصوره جورجيو أغامبن. إبستين ليس خارج القانون؛ إنه في قلب عمل القانون وفقاً للفرد. هنا يأتي دور مفهوم جورجيو أغامبن عن ”حالة الاستثناء“. تخلق القوى الحاكمة ”مناطق استثنائية“ حيث يتم تعليق القانون من أجلها. جزيرة إبستين هي ”منطقة رمادية“ حيث يتم تعليق القانون جغرافياً وقانونياً. لو كان هذا مجرد ”شذوذ“، لكان آلية الدفاع عن النظام (القضاء، وسائل الإعلام، الشرطة) قد تدخلت في وقت أبكر بكثير. عقود من الصمت تشير إلى أن هذا ليس ”خللاً“ جوهرياً، بل ’ثمن‘ أو ”أداة“ تقبلها طبقات معينة من النظام.
تقدم ملاحظة كارل شميت الشهيرة مفتاحًا حاسمًا هنا. ”السيادة هي التي تقرر الاستثناء“. يبني النظام الحديث طبيعته من خلال الاستثناءات؛ لكن هذه الاستثناءات غالبًا ما لا تكون لحظات يتم فيها تعليق القاعدة، بل عتبات تكشف الوجه الحقيقي للقاعدة. الحكام الوحيدون للعالم الرأسمالي هم الرأسماليون. قضية إبستين، حيث لا يعمل القانون، وتُعلق المساءلة، وتُسكت وسائل الإعلام، وتدخل شبكات الاستخبارات، ليست فراغًا ”عرضيًا“ أنتجته الحداثة، بل هي منطقة رمادية خلقتها السلطة لحماية نفسها. هذه المنطقة الرمادية ليست شذوذًا أو مرضًا في الحداثة، بل هي أداة ونتيجة معتادة لعقلانية السلطة ورأس المال. لذلك، فإن إبستين ليس استثناءً حيث ”انهار“ القانون الحديث؛ بل هو حالة تكشف لمن يمكن تعليق القانون الحديث أو مدى سهولة استغلاله.
تستند الحداثة الغربية إلى العقلانية وحقوق الفرد. ومع ذلك، كشفت قضية إبستين أيضًا عن علاقات القوة ”الإقطاعية“ الكامنة وراء هذه العقلانية. في العالم الحديث حيث المعلومات هي القوة، استخدم إبستين ”المعلومات“ (أو الأشرطة/الأدلة) كسلاح، ووسيلة للابتزاز. وهذا في الواقع أقدم وأظلم أشكال أساليب الاستخبارات الحديثة. وهو ليس حصريًا على الولايات المتحدة، بل هو وضع انتشر في جميع أنحاء الشبكات العالمية الغربية. ويُظهر النطاق، الذي يمتد من الأوساط الأكاديمية (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) إلى العائلات الملكية (الأمير أندرو)، أن القضية ليست قضية جنائية منعزلة، بل هي علامة على الانحلال الهيكلي والفساد والإفلاس والفساد. قضية إبستين ليست ”شذوذًا“ في العصر الحديث، بل هي انعكاس للجانب المظلم للعصر الحديث في مرآة الغرب. على الرغم من أن النظام يحاول استعادة شرعيته من خلال ”تنظيف“ هذه القضية، فإن حقيقة أن هيكلًا بهذا الحجم يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وأنه تم تنفيذه بشكل احترافي للغاية، تكشف مدى اتساع الفجوة بين السلطة والأخلاق في العالم النيوليبرالي. وعدتنا الحداثة بالتنوير، لكن قضايا مثل قضية إبستين تظهر بوضوح كيف يمكن أن تكمن ظلال كبيرة تحت هذا التنوير/النور. (للاطلاع على قصة تحذيرية عن الجانب المظلم للتنوير، انظر كتاب روبرت دارنتون The Great Cat Massacre).
من منظور نفسي، تسلط الأدبيات ما بعد الفرويدية، لا سيما من خلال مفاهيم (Trieb) ومبدأ المتعة ودافع الموت (Todestrieb)، الضوء على الترابط بين الانحراف الفردي والبنية الثقافية. ومع ذلك، تذكرنا علم النفس النقدي المعاصر أيضًا أن الميل إلى اختزال مثل هذه الحالات إلى مجرد أمراض فردية يحجب بشكل منهجي المسؤولية الاجتماعية. كما أشار كريستوفر لاش في عمله عام 1979 ثقافة النرجسية: العواقب الشخصية لعصر الانغماس في الذات (Alfa Yayınları 2021)، في المجتمعات الرأسمالية المتأخرة، تتشكل هياكل الشخصية حول محوري القوة والمتعة، بينما تصبح الحدود الأخلاقية أكثر مرونة. أكثر تدخلات لاش إثارة للجدل، وربما الأكثر ديمومة حتى اليوم، هو استخلاص النرجسية من علم النفس السريري الضيق وتشخيصها كأحد الأعراض التاريخية والثقافية والسياسية للمجتمع البرجوازي الحديث. بالنسبة إلى لاش، النرجسية ليست مجرد اضطراب عقلي يحدث في العالم الداخلي للفرد ”المحب لنفسه“، بل هي بنية شخصية اجتماعية ظهرت في المرحلة المتأخرة من الحداثة الرأسمالية، وانتشرت على نطاق واسع، وأصبحت تقريبًا هي القاعدة. يستعير لاش افتراضًا أساسيًا من النظرية الفرويدية، لكنه يعيد صياغته بشكل نقدي. ”البنى العقلية الفردية ليست فردية أبدًا؛ بل تحمل بقايا الصدمات التاريخية، والتنظيم الاقتصادي، والأيديولوجيات السياسية، والروايات الثقافية.“ لذلك، يفسر لاش ارتفاع اضطراب الشخصية النرجسية على أنه نتيجة متناقضة للازدهار والأمن والهيمنة التي شهدتها المجتمع الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية. مع انخفاض التهديدات الخارجية، نما فراغ داخلي، حل الأداء محل المعنى، وحلت الصورة محل الشخصية، وحل خطاب ”الرفاهية“ النفسية محل الأخلاق. والأهم من ذلك، أن لاش لا يعرّف النرجسية على أنها مرض النخبة أو انحراف هامشي، بل كسمة أساسية للثقافة البرجوازية للطبقة الوسطى. وفقًا له، فإن الذات النرجسية قلقة وهشة وتسعى باستمرار إلى الحصول على الموافقة، وفي الوقت نفسه جشعة، ولكن هذا الجشع رمزي وليس ماديًا، ويغذيه الرغبة في الشهرة والتقدير والاعتراف و”التميز“. هذا النوع من الذات هو بالضبط النوع الذي تحتاجه المجتمع الرأسمالي. لأن الأفراد الذين لا جذور لهم، ويفتقرون إلى الوعي التاريخي والشعور بالمسؤولية طويلة الأمد تجاه المستقبل، يسهل دمجهم في نظام الاستهلاك والمنافسة.
في عالم الفكر ما قبل الفرويدي —سواء كان مفهوم أرسطو عن الأكراسيا (ضعف الإرادة)، أو نقد أوغسطينوس لـ الكونكوبيسينتيا (الشهوة)، أو نظريات الذات لفارابي وابن مسكويه والغزالي في التقاليد الأخلاقية الإسلامية—يُفهم مثل هذا السلوك في المقام الأول على أنه انحراف أخلاقي. عندما يفقد البشر التوازن الذي يتحملون مسؤولية إقامته والحفاظ عليه بين العقل (aql) وقوى الشهوة (shahwa) والغضب (ġaḍab)، فما يظهر ليس ”مرضًا“ بقدر ما هو اضطهاد؛ تعدّي، خيانة للأمانة تجاه الذات والآخرين. في هذا السياق، فإن أفعال إبستين، معبراً عنها بالمصطلحات الكلاسيكية، هي هيمنة النفس الأمارة. علاوة على ذلك، فإن استمرارية الأفعال غير الأخلاقية وهيكلها المنظم يزيدان من تفاقم هذا الانحطاط الأخلاقي. فكما يقول الفارابي (المدينة الفاضلة)، عندما تصبح الرذائل الفردية مؤسسية على نطاق مجتمعي، فإن المسألة لم تعد تتعلق بالفرد، بل بـفساد مفهوم الحضارة. لذلك، وبتعبير ما قبل فرويد، فإن إبستين ليس ”مريضًا“، بل فاسدًا وغير أخلاقي. اسم المشكلة ليس علم الأمراض، بل الانحطاط الأخلاقي. ومع ذلك، مع فرويد، أحدث الفكر الحديث تغييراً جذرياً في العلاقة التي تربط البشر بأنفسهم. لم يعد يُنظر إلى البشر على أنهم مجرد كائنات واعية، بل ككائنات معقدة تشكلها اللاوعي (das Unbewusste)، والدوافع المكبوتة (Triebe)، ومبدأ المتعة (Lustprinzip)، والرغبة القهرية في التكرار (Wiederholungszwang) (فرويد، ما وراء مبدأ المتعة). من هذا المنظور، يمكن قراءة قضية إبستين من منظور التحليل النفسي على أنها انحراف (أفعال إجرامية)، أو حتى، باستخدام مصطلحات لاكان، على أنها توسع غير محدود في التمتع (المتعة) (لاكان، المفاهيم الأساسية للتحليل النفسي).
وبناءً على ذلك، فإن الادعاء بأن إبستين ”مريض“ لا يمكن أن يكون ذا معنى إلا في حالة واحدة. هذا المرض ليس انحرافًا فرديًا سريريًا وجنائيًا، بل هو مرض اجتماعي يغذيه السلطة والثروة والحصانة. إن السؤال ”أهو فساد أم مرض؟“ الذي سيُطرح بشكل خبيث في قضية إبستين هو، في رأيي، ثنائية زائفة. فما نتعامل معه هنا ليس فشلًا أخلاقيًا بحتًا ولا اضطرابًا طبيًا بحتًا. فما نواجهه هنا هو مرض عادي انهارت فيه الحدود الأخلاقية وفشل النظام فشلاً ذريعاً. يمكن لمفهوم هانا أرندت عن ”تفاهة الشر“ (die Banalität des Bösen) أن يفسر إلى حد ما تطبيع هذا المرض. أفعال إبستين استثنائية بقدر ما هي مبتذلة. وذلك لأن هذه الأفعال وقعت داخل شبكة، وبيئة، ودرع واقي. كما يشير فوكو، فإن السلطة الحديثة لا تستبعد الشذوذ؛ بل تنتجه وتديره (ولادة السجن). تعد قضية إبستين مظهراً متطرفاً ولكنه نموذجي لعمليات تسليع الرغبة، وتشييء الجسد، وإضفاء الطابع الجنسي على السلطة في المجتمع الرأسمالي المتأخر (باومان، الحداثة السائلة؛ هان، المجتمع المتعب). في جوهرها، تنطوي هذه الحالة على وضع الذات ليس كـخادم بل كسيد مطلق. في المصطلحات الإسلامية، هذا هو tuğyân وistikbâr. في اللاهوت الغربي، إنها مأساة استبدال الذات بالله (تأليه الذات). قضية إبستين ليست فسادًا فرديًا أو مرضًا سريريًا؛ إنها اسم آخر للعالم المظلم الذي يصل إليه النظام الحديث للرغبة عندما يتحد مع السلطة ورأس المال. لذلك، فإن إعلان إبستين ”مريضًا“ قد يعفي النظام من المسؤولية، ووصفه بـ”الفاسد“ يعني التستر على العديد من الحقائق.
أكثر جوانب قضية إبستين ظلمة هو أن جميع العلاقات والابتزازات والمؤامرات التي تم إقامتها بطريقة ما تمتد إلى إسرائيل وأولئك الذين شكلوا شراكات معها. على سبيل المثال، إدراج رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك في ملف إبستين ليس مصادفة ولا صدفة. كما أن غياب الشخصيات النشطة في السياسة الإسرائيلية عن الملف ليس مصادفة، بل استراتيجية. لفهم كيف أصبحت إسرائيل واليهود الصهيونيون بلاءً على هذا العالم، أعتقد أنه يكفي النظر إلى النظام العالمي الرأسمالي. على مر التاريخ، ظل اليهود دائمًا على هامش المجتمعات المهيمنة. سعوا باستمرار إلى إيجاد مكانهم في النظام الذي أنشأه الآخرون كأقلية. ربما لأول مرة في التاريخ، أصبحوا مهيمنين إلى هذا الحد. لأول مرة، نعيش في نظام أنشأه اليهود. كان للمسيحيين إمبراطوريات عظيمة مثل روما وبيزنطة، وكان للمسلمين دول عالمية مثل العباسيين والسلاجقة والعثمانيين. لكن لأول مرة في التاريخ، أنشأ اليهود إمبراطورية غير مسماة على نطاق عالمي. سبب وجود هذه الإمبراطورية هو جعل جميع الدول الكبرى مدينة لها، مع الرأسمالية كنظام اقتصادي، والنيوليبرالية كأسلوب حياة، والمال كإله، والسرية كأسلوب، والتضحية بجميع الأشخاص خارج أيديولوجيتها كهدف. إيبستين هو شخصية نموذجية تجسد سبب وجود النظام وأسلوب حياته، وكذلك أسلوبه وهدفه. طالما ظل العالم بأسره تحت سيطرة هذه الأيديولوجية اليهودية المتنكرة في شكل الرأسمالية، فلن يختفي أمثال إبستين. على سبيل المثال، فيلم Eyes Wide Shut الذي أخرجه ستانلي كوبريك عام 1999، تضمن بالفعل أجزاء من شخصية إبستين. أو رواية أندرو نيدرمان لعام 1990، التي تم تحويلها إلى فيلم The Devil’s Advocate عام 1997، وفيلم The Wolf of Wall Street عام 2013، وكأنهما بروفة لشر إبستين المنظم والقانوني.
إبستين ليس له شخصية، بل مصالح فقط. تمامًا كما في الشعار الأساسي للرأسمالية، فإن جميع الطرق التي تؤدي إلى مصالحه مسموح بها له. للوهلة الأولى وعلى السطح، تبدو قضية إبستين مناسبة تمامًا لتقديمها كمثال استثنائي على عدم الأخلاق، حيث تقف عند تقاطع الثروة المفرطة والرغبة المنحرفة والجريمة والنخب الفاسدة وشبكة من العلاقات المشبوهة. في الواقع، كل من خطاب وسائل الإعلام الرئيسية والرواية القانونية الرسمية تميل إلى وصف هذه القضية بأنها ”جريمة استثنائية لفرد استثنائي“، وبالتالي تبرئة النزاهة الأخلاقية والمؤسسية للمجتمع الحديث. قضية إبستين ليست حادثًا مؤسفًا للحداثة ولا انحرافًا واستثناءً خارج نطاق النيوليبرالية. بل على العكس، إنها إحدى اللحظات التي تواجه فيها الحداثة النيوليبرالية نفسها، الحقيقة المجردة لأسلوب الحياة النيوليبرالي. إذا أردنا تجسيد أسلوب الحياة النيوليبرالي وتقديمه في شكل بشري، فسيظهر أمامنا بلا شك على شكل إبستين. إذا حلت منطق السوق محل الأخلاق، وإذا أصبحت السلطة غير خاضعة للمساءلة، وإذا تم اختزال الجسد إلى مجرد قيمة تبادلية، وإذا تم اختزاله إلى مبدأ المتعة، وإذا تم استغلال البشر، وإذا تم تبرير الشر المتعمد والمنظم، وإذا تم النظر إلى المال والسلطة والعلاقات والصلات والشبكات على أنها ذات قيمة في حد ذاتها، فإن مثل هذه الأحداث تتوقف عن كونها استثناءات، ليصبحوا شركاء سريين للنظام. وبالتالي، يصبحون النظام نفسه. ما يحدث هو بالفعل أوضح مظهر لهذا. لهذا السبب لا يعتبر إيبستين فضيحة يمكن نسيانها. على العكس، إنه حدث تحذيري يجب تذكره دائماً. تماماً مثل الإبادة الجماعية في البوسنة، وغزو العراق، ومذبحة غزة.