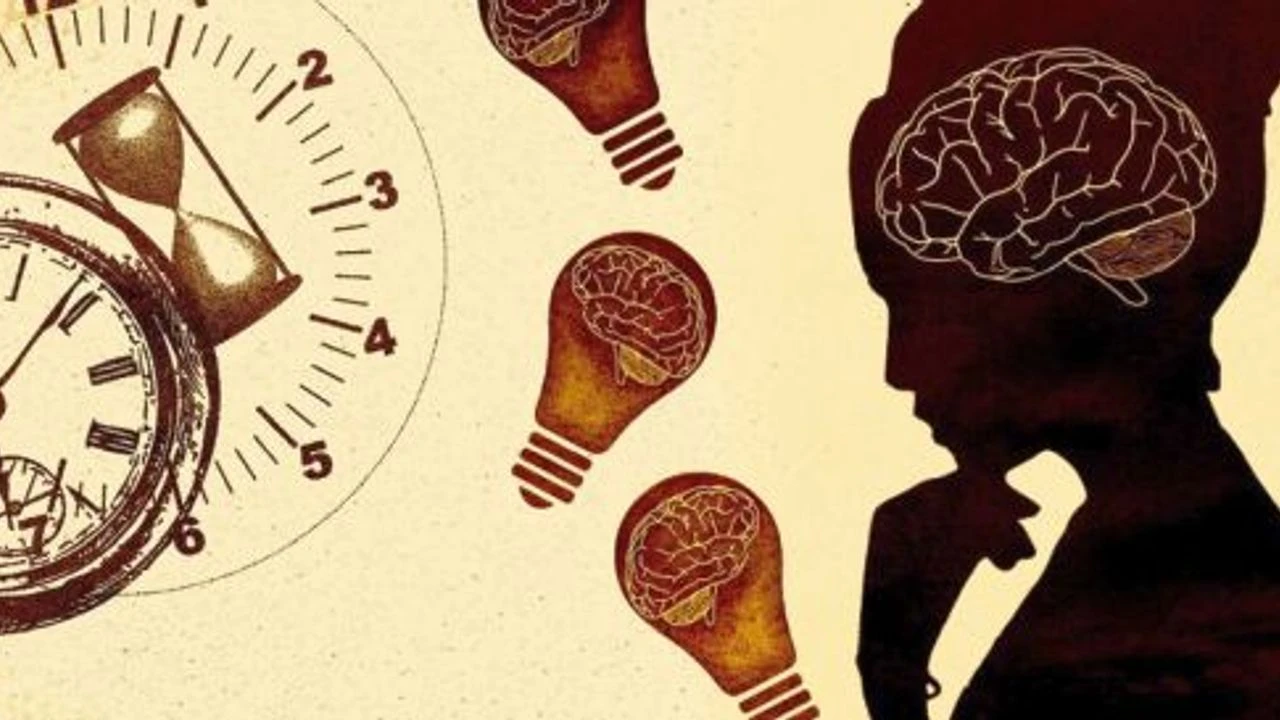عندما يظهر شخص معني بالفلسفة في وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا، غالبًا ما يجادل بأن العقبة الوحيدة أمام ممارسة الفلسفة هي المعتقدات والتقاليد الدينية للمجتمع، ويصر على أنه بدون التحرر من هذه المعتقدات والتقاليد، لا يمكننا التفكير ”بحرية“ أو الانخراط في الفلسفة. بغض النظر عن سياق حججهم ونقطة انطلاقها، فإن النتيجة دائمًا ما تكون نفس القصة. نظرًا لأن مشروع التحديث خلال الانتقال من الإمبراطورية العثمانية إلى الجمهورية تم تعريفه على أنه معارضة للدين والتقاليد، فإن الانتقادات الموجهة في هذا الاتجاه تحظى بمكانة مألوفة ومشروعة في الخطاب العام. حتى أولئك الذين ينتقدون الدين بناءً على أسباب ”عقلانية“ فقط، بدلاً من التقليل من شأنه، لا يدركون أنهم يوجهون هذه الانتقادات في عالم رأسمالي. وذلك لأن النظام الرأسمالي يستخدم انتقاد الدين والتقاليد كـ”ستار شرعية“ يعزز هيمنته. وبالتالي، تصبح العلاقات الحقيقية للسلطة والهياكل الاقتصادية وأشكال الإنتاج الثقافي غير مرئية. في وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية، تعمل وسائل الإعلام والتعليم والفنون، التي هي أدوات للهيمنة الثقافية الرأسمالية، على تآكل القدرة الأساسية للفلسفة على النقد. لذلك، فإن النقد الموجه للدين والتقاليد، طالما أنه لا يمس آليات عمل الرأسمالية، يصبح شكلاً من أشكال المعارضة التي يتسامح معها النظام الرأسمالي باعتباره ”ولداً مطيعاً“.
قد تكون هناك بالفعل مشاكل في أشكال المعتقدات والتقاليد في المجتمع. في الواقع، هناك مشاكل. ومن المؤكد أنه من الممكن التعبير عنها وانتقادها. لكن قصر النقاش على هذا الأمر وعدم رؤية المشكلة الحقيقية هو، في رأيي، علامة واضحة على الجهل والامتثال. فمن السهل جدًا التعامل مع معتقدات المجتمع وتقاليده، و”التغلب“ عليها والتقليل من شأنها؛ أما الصعب فهو التعامل مع النظام الرأسمالي نفسه، الذي أصبح قمعًا مهيمنًا ومتأصلًا في عظامنا. ولهذا السبب، يفضل معظم الأشخاص الذين يتم تقديمهم على أنهم فلاسفة في وسائل الإعلام الطريق السهل. قد يكون خطابهم جميلاً، وبلاغتهم رائعة، وقد يتحدثون من منطلق فلسفي للغاية. ومع ذلك، في اللحظة التي يتجاهلون فيها المشكلة الحقيقية، يمكن أن تفقد خطبهم الجميلة تأثيرها فجأة. لذلك، فإن حقيقة أن الشخصيات التي يتم تقديمها على أنها ”فلاسفة“ في وسائل الإعلام تتجاهل باستمرار القضية الحقيقية ليست مجرد خيار فردي؛ بل هي أيضًا نتيجة مرشح خطاب هيمني. بغض النظر عن مدى إثارة إعجابنا بخطابهم وغنى مفاهيمهم ومراجعهم الفلسفية، فإن النقد الفلسفي الذي لا يمس الرأسمالية يخاطر بأن يصبح ملحقًا يزين النظام نفسه، تمامًا كما في تعريف أدورنو لـ ”صناعة الثقافة“. لذلك، عندما يتناول هؤلاء ”الفلاسفة“ (أنت تعرفهم جيدًا، لذا لا داعي لذكر أسمائهم؛ فهم يعرفون أنفسهم جيدًا) النظام الرأسمالي، يمكنك أن تكون على يقين من أنهم بدأوا ”يفكرون“. وبناءً على ذلك، فإن السؤال الحقيقي هو: هل يمكن ممارسة الفلسفة في عالم رأسمالي؟
من ناحية أخرى، فإن السؤال ”هل يمكن ممارسة الفلسفة في عالم رأسمالي؟“ ليس مجرد فضول فكري مجرد بالنسبة لي؛ بل هو في صميم استفسار مهني واجتماعي وشخصي. بصفتي محاضرًا في الفلسفة، أشعر أنني مضطر لطرح هذا السؤال لفهم أسباب العقبات التي أواجهها عندما أحاول إيصال وجهة نظري إلى معظم طلابي. إن التوتر بين الطبيعة البطيئة والعميقة والنقدية للفلسفة والروح السريعة والسطحية والموجهة نحو الكفاءة للعالم الرأسمالي محسوس في خلفية صعوبات التواصل في الفصل الدراسي. هذا السؤال يهمني أيضًا بصفتي عضوًا في الجامعة. تشكلت الجامعة الحديثة خلال عملية الفصل المؤسسي بين العلوم؛ فمع تزايد تخصص العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية في مجالاتها الخاصة، فقدت الفلسفة مكانتها المركزية. ومن المثير للاهتمام أن هذا الفصل يتزامن تاريخياً مع صعود النظام الرأسمالي. منذ القرن التاسع عشر فصاعدًا، أعيد تنظيم علاقات الإنتاج وأشكال إنتاج المعرفة العلمية لتتوافق مع منطق السوق. وهكذا، أصبحت الفلسفة مهمشة بشكل متزايد، سواء داخل الجامعة أو في المجال العام، لأنها لم تنتج ”فوائد مباشرة“. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتخاذ موقف فلسفي في المجتمع الذي أعيش فيه ينطوي على صعوبة خاصة في بيئة ترسخ فيها الرأسمالية. لا تعمل الروح الرأسمالية كنظام اقتصادي فحسب، بل أيضاً كهيمنة ثقافية تشكل طرق التفكير والقيم وقنوات الاتصال. إن التعبير عن النية الفلسفية في ظل هذه الظروف يعني التعامل ليس فقط مع العقبات المفاهيمية، بل أيضاً مع التصورات الاجتماعية ولغة السوق وثقافة السرعة. ليس فقط المجتمع الذي أعيش فيه، بل العالم بأسره يخضع لهيمنة الرأسمالية. حتى المنافسون المفترضون مثل الولايات المتحدة والصين يشتركون في كونهم رأسماليين. تظهر هذه الصعوبات أن البيئة التي تمارس فيها الفلسفة تؤثر بشكل مباشر على طريقة ممارسة الفلسفة وأسبابها. باختصار، العالم الذي تمارس فيه الفلسفة مهم للغاية.
لا تعتمد إمكانية ممارسة الفلسفة على القدرة الفطرية على التفكير التي يوفرها العقل البشري فحسب، بل تعتمد أيضًا على السياق الاجتماعي والثقافي والتاريخي الذي يغذي هذه القدرة. لا يمكن تفسير ظهور الفلسفة في اليونان القديمة فقط بعبقرية سقراط أو أفلاطون أو أرسطو؛ فقد ساهمت البنية السياسية للمدينة، وفهم المواطنة، والعلاقات التجارية، والشكل المؤسسي لأوقات الفراغ (scholé)، وثقافة النقاش الاجتماعي في تهيئة هذه الأرضية. لا يفكر كل فيلسوف بعقله فحسب، بل كعضو في المجتمع الذي يعيش فيه. لذلك، حتى الانتقادات الأكثر قسوة تُعتبر ردود فعل على القواعد الثقافية والأخلاقية السائدة في ذلك الوقت. حتى عندما يعارض الفيلسوف شيئًا ما، يجب عليه أن يتحدث بلغة القيم الاجتماعية التي هي موضوع معارضته. في هذا السياق، فإن السؤال الحقيقي هو ما هي إمكانية ممارسة الفلسفة في عالم تهيمن عليه الروح الرأسمالية النيوليبرالية المعولمة والمكثفة اليوم. لأن الرأسمالية لا تغير العلاقات الاقتصادية فحسب، بل تغير أيضاً تصورات الزمن، وأشكال الانتباه، والقيم الاجتماعية، وحتى فهم الفرد نفسه. لذلك يمكننا صياغة السؤال على النحو التالي: كيف تشكل الروح الرأسمالية طرق التفكير وتأثير الفلسفة على الجمهور؛ هل يمكن للفلسفة أن تحافظ على وظيفتها التحررية والنقدية في ظل هذه الظروف؟ في بيئة أصبح فيها الناس من ناحية أشياء للاستهلاك، ومن ناحية أخرى يكافحون من أجل البقاء، هل يمكننا حقًا أن نتحدث عن التفكير والفلسفة؟ في عالم تهيمن عليه الشركات والمؤسسات، حيث ينتشر عالم الإعلان والصورة، وحيث المال هو العملة الوحيدة، هل يمكن للناس حقًا أن يفكروا في أمور مثل الأخلاق والسياسة والدين والجماليات والقانون؟
في الماضي، كان يُقال إن الدين أو التقاليد تفرض قيودًا خارجية على الفلسفة، مثل ”لا يمكنك التفكير في هذا المجال“. لكن النظام الرأسمالي لا يستبعد الفلسفة بقدر ما يدمجها ويحولها بشكل خفي. أي أنه يسمح بممارسة الفلسفة، لكنه إما يروضها وفقًا لمنطق السوق أو يدفنها في المناقشات الفنية لأقسام الفلسفة. في الواقع، هناك العديد من أقسام الفلسفة في العديد من البلدان حول العالم. لذلك، فإن الخطر اليوم ليس حظر الفلسفة، بل انتشار فلسفة زائفة تبدو وكأنها فلسفة ولكنها تُرجمت إلى لغة السوق. في الماضي، كان يُنظر إلى اللاهوت والتقاليد على أنهما منافسان للفلسفة، ولكن اليوم النظام الرأسمالي هو أقوى هيكل هيمنة معارض للفلسفة. ضمن حدود هذه الهيمنة، تمارس فلسفة ”آمنة“ و”غير ضارة“. هذا المنافس الجديد للفلسفة لا يعمل من خلال فرض حظر مباشر كما في الماضي، بل من خلال طريقة أكثر دقة: تسويق الفكر وجعله غير فعال. لذلك فهو أكثر خطورة وخبثًا.
في مقاله ”الفلسفة ودراسة الرأسمالية“ (2022)، يذكر جاستن إيفانز أن علماء الاجتماع والاقتصاد والأنثروبولوجيا والنقاد الأدبيين قد أجروا الكثير من الأبحاث حول الرأسمالية، ولكن الفلسفة أبدت أقل اهتمام بهذا المجال. لماذا لم يكن الرأسمالية أحد المشاكل الأساسية للفلسفة؟ هذا الإغفال وحده كافٍ لاعتباره خطيئة وعارًا ووصمة عار على الفلسفة. إن فشل الفلسفة في رؤية الرأسمالية كمشكلة هو، في الواقع، محاولة انتحار.
في كتابه الذي نُشر مؤخرًا، ”نهاية الفكر: موت الفلسفة 1“ (İnsan Yayınları 2025)، يوضح علي سعيد صادق أوغلو بوضوح ودقة أن الرأسمالية هي أحد الأسباب الرئيسية لموت الفلسفة. وفقًا لصادقوغلو، أصبح البشر الآن كائنات تُعرّف فقط من خلال أنانيتهم وأجسادهم، وتشكلت حول الفردية الاقتصادية والاندفاعات والمصالح. لقد حوّل النظام الرأسمالي الليبرالي الجسد إلى آلة أداء، ففصل الإنسانية عن المتعالي وحوّلها إلى موضوع للعقل الوسطي، وبالتالي حرم الفلسفة من سبب وجودها. في هذا السياق، تم حصر الدين في المجال الجمالي الجوهري للضمير الفردي؛ وأصبح الإيمان خيارًا تخمينيًا. وفي الوقت نفسه، يبني الاقتصاد الإيمان على الأداء والإنتاجية، مستغلاً المقدس بشكل كامل. وفي هذه العملية، تم اختزال المقدس إلى مجرد حنين رمزي. بعد أن فقد الفرد المتعالي مع الدين، أصبح حيوانًا عديم الروح وعلمانيًا، لا يوجد إلا من خلال جسده. أصبحت الديمقراطية أداة لهيمنة رأس المال، وأصبحت الأنظمة التمثيلية معطلة. في النظام الليبرالي، تحمل جميع الهياكل السياسية اتجاهات شمولية. حتى الشيوعية فشلت في تغيير هذه العملية المادية. (في الواقع، لا يقضي نوع من المادية على نوع آخر من المادية؛ بل يجعله أقوى، وهو بالضبط ما فعله ماركس والماركسية). ونتيجة لذلك، تم استغلال العالم، مع طبيعته وإنسانيته؛ وتغلغلت منطق الرأسمالية الكلي في كل شيء. لم يعد الفرد، الذي شكلته منطق رأس المال، موضوعًا يحمل مبادئ أخلاقية عالمية. (ص 13-20)
في القرنين الماضيين، تجاوزت دراسات ”تاريخ الفلسفة“ بوضوح المساعي الفلسفية الأصلية. (حوالي 70٪ أو أكثر من الدراسات الفلسفية تتناول تاريخ الفلسفة). والسبب الأساسي لذلك هو أن النظام الأكاديمي الرأسمالي يشجع إنتاج أعمال آمنة ومتوافقة مع المعايير وأبحاث قابلة للقياس وتولد اقتباسات، في حين أن الفلسفة الأصلية الجريئة والراديكالية والبانية للنظام تعتبر ”مغامرة“ أو ’خطيرة‘ أو ”طوباوية“ من منظور مؤسسي. إذا فُهمت الفلسفة ليس فقط على أنها معرفة نظرية، بل أيضاً كطريقة حياة (كما في تفسير بيير هادوت للفلسفة القديمة)، فإن ممارسة الفلسفة في العالم الرأسمالي تصبح، في حد ذاتها، عملاً مضاداً للثقافة أو حتى عملاً من أعمال المقاومة. يجب أن تقدم الفلسفة رؤية بديلة للحياة لقيم الرأسمالية المتمثلة في ”الكفاءة“ و”المنافسة“ و”الاستهلاك“. ومع ذلك، غالبًا ما يُصنف هذا على أنه ’هامشي‘ أو ”غير فعال“ داخل النظام. لذلك، فإن ممارسة الفلسفة في عالم رأسمالي لا تعني فقط التفكير، بل المقاومة أيضًا.
ينتقد مارتن هايدغر بنية الرأسمالية، التي تمجد العقل التقني، بمفهوم ”Gestell“ (الإطار). وفقًا لهايدغر، ترى التكنولوجيا الحديثة الوجود فقط كمورد قابل للحساب والاستخدام. ضمن هذا ”التفكير الحسابي“، يصبح من المستحيل بشكل متزايد على الفلسفة أن تطرح سؤال الوجود. يقترح هايدغر ”التفكير التأملي“ (besinnliches Denken) الذي يقدم التباطؤ والانتظار وإعادة الانخراط في الوجود كرد فعل على منطق السرعة في الرأسمالية. وفقًا لـ جان بودريلارد، فإن المجتمع الاستهلاكي يخلق نظامًا يتم فيه استهلاك الرموز والصور، وليس الاحتياجات. في هذه البيئة، تخاطر الفلسفة بأن تتحول إلى ”متجر مفاهيم“ يغذي إنتاج الصور بدلاً من البحث عن الحقيقة. يؤكد بيونغ-تشول هان أن الرأسمالية النيوليبرالية، على عكس المجتمعات التأديبية الكلاسيكية، تحول الفرد إلى حاكم مستبد لنفسه. في ”مجتمع التعب“، ينهك الفرد الضغط المستمر على الأداء. في هذا السياق، لا تعتبر الفلسفة مجرد نقد للنظام، بل هي أيضًا ممارسة لإعادة بناء الحرية الداخلية للفرد. وفقًا لهان، فإن ممارسة الفلسفة في العالم الرأسمالي تعني تطوير ”جماليات السلبية“ في مواجهة ضغط ”الإيجابية“.
تزيل الرأسمالية الفلسفة من كونها جزءًا عضويًا من الحياة اليومية والسياسة والأعمال والإعلام، وتقصرها إلى حد كبير على المؤسسات الأكاديمية. وذلك لأن النظام الرأسمالي يبدأ في التوقف عندما تدخل الفلسفة في النظام الرأسمالي. عندما تشكك في ما تعلمته، تتوقف الأمور. لهذا السبب أصبحت الجامعات بشكل متزايد ”مراكز لإنتاج المعرفة المعتمدة“ في المجتمع الرأسمالي. تُعتبر أقسام الفلسفة ”هامشية“ أو ’غريبة‘ أو ”عجيبة“ باعتبارها مجالًا لا يدر دخلاً مباشرًا في السوق، حيث تجري المناقشات الفنية، ولا يفهمه أحد حقًا. هذا الوضع يخضع إلى حد كبير الإمكانات النقدية للفلسفة لشكل المقالات الأكاديمية، وعدد الاقتباسات، وتمويل المشاريع، والنتائج القابلة للقياس. وهي تسعى إلى الحفاظ على وجودها ليس من خلال التضارب مع النظام الرأسمالي، بل من خلال تحديد عيوبه وإصلاحها، وإعادة تأهيلها إذا لزم الأمر. في كليات الحقوق، لا تعتبر الفلسفة القانونية مسعى/سعيًا يعكس روح فهم سبب وجود القانون وتطبيقه بشكل عادل، بل هي آفة مفروضة بشكل قسري ويجب الهروب منها في أسرع وقت ممكن من خلال الحصول على درجة النجاح. في أقسام الاقتصاد، عندما تدخل قوة التساؤل الفلسفية حيز التنفيذ، يتوقف النظام تدريجيًا عن العمل. لا يمكنه حتى تعريف مفاهيم ”الرغبة“ و”الحاجة“ بشكل صحيح. (قد ترن آذان İşaya Üşür). في النهاية، يتقلص الدور العام للفلسفة؛ لم يعد الفلاسفة يتحدثون في الأغورا، بل غالبًا ما يتحادثون مع بعضهم البعض بـ”لغة خاصة“ في أروقة الكلية.
على عكس الاعتقاد الشائع، لا يدمر الرأسمالية الفلسفة تمامًا؛ بل على العكس، يدمجها في منطق السوق بطريقة محكومة. غالبًا ما تركز أنشطة مثل ورش العمل ”الفلسفية“ ومخيمات ’اليقظة‘ وندوات ”أخلاقيات الشركات“ على الأداء الشخصي والإنتاجية أكثر من التفكير النقدي. وبالتالي، لم تعد الفلسفة أداة مقاومة للنظام، بل أصبحت قطاع خدمات يلمع صورة النظام. لا يقضي النظام الرأسمالي على الفلسفة تمامًا، بل يحد منها مكانيًا (بقصرها على أقسام الجامعات) ووظيفيًا (بتكييفها مع منطق السوق). لذلك، فإن ممارسة الفلسفة اليوم تعني في كثير من الأحيان محاولة إعادة بناء المجال العام من خلال الخروج من هذا ”السجن المؤسسي“.
من المفارقات أن الرأسمالية أنتجت أفرادًا أنانيين من الناحية الهيكلية، ومشتتين من الناحية الاجتماعية، وعاجزين من الناحية السياسية. إنهم أنانيون في مواجهة الفوز والاستهلاك، وممزقون ومكتئبون لأنهم يجهلون معنى التضامن، وعاجزون لأنهم بيادق التصويت في لعبة الديمقراطية السياسية. في هذه الأجواء، من المستحيل الحديث عن تفكير الفرد. فالأنانية الهيكلية هي أكبر خطر ومصدر للخداع لأنها تقضي على عجز الفرد وقيوده في مواجهة الحقيقة. من الناحية الاجتماعية، يمنع التفتت الفرد من أن يصبح موضوعًا أخلاقيًا لأنه يجعله غير مبالٍ بالآخرين. من الناحية السياسية، يحرمه العجز من القدرة على انتقاد الممارسات القائمة والتشكيك فيها. ما يتبقى هو أفراد زائفون يخدعون أنفسهم بالمصطلحات والمشاكل الفلسفية. كما يقول بيونغ تشول هان في كتابه مجتمع الإرهاق، فقد حوّل الرأسمالية النيوليبرالية الفرد إلى ”موضوع أداء يستغل نفسه“. ينتج هذا الموضوع عزلة تنافسية في علاقاته مع الآخرين بدلاً من المسؤولية الأخلاقية. تؤدي العزلة الرأسمالية بالفرد ليس فقط إلى الاكتئاب، بل أيضاً إلى العمى الأخلاقي.
ممارسة الفلسفة في عالم رأسمالي أمر صعب وضروري في آن واحد. إنه صعب لأن منطق السوق يتعارض مع طبيعة التفكير البطيئة والعميقة والنقدية والحرة. وهو ضروري لأن الفلسفة هي، أو ينبغي أن تكون، أحد المجالات النادرة التي يمكن للبشر فيها الحفاظ على وجودهم الفكري في مواجهة منطق السرعة والتسليع/التجسيد هذا. وإلا، فإن الفلسفة تخاطر بأن تصبح حل ألغاز، وحفريات أثرية، وتهمس بمصطلحات تقنية، وتصبح صلصة النظام الرأسمالي، ووسيلة للراحة من خلال محاربة معتقدات وتقاليد المجتمع الذي تعيش فيه، أو مغامرة للحصول على حصة اقتصادية دون أن يتم مراقبتك رقمياً.